مقدمة موسوعة السرد العربي
السردية العربية: مسارات صعبة
استغرق العمل على هذه الموسوعة نحو عشرين سنة. بدأ الإعداد لمادّتها الأولية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وتواصل بعدها، ولم ينقطع البحث في السرد العربي قديمه وحديثه منذ ذلك الوقت، ولكن من التمحّل القول بأن مشروع إعداد موسوعة تتتبّع نشأة السرديات العربية منذ العصر الجاهلي إلى نهاية القرن العشرين، ثم تتقصّى أبنيتها السردية والدلالية، كان واضحا في ذهني، جاهزا لا ينقصه سوى التنفيذ؛ فذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة، بل إنني أستطيع القول بأن فكرة الموسوعة بدأت تلوح لي في منتصف التسعينيات، حينما وجدت دراساتي في مجال السرد تتسع، وتتراكم، وتغطّي حقبا متتالية، فشرعت أعيد التفكير في الطريقة التي أكيّف فيها الدراسات والبحوث المنجزة والمخطط لها، بما يجعلها تخدم الغرض الذي أطمح إليه، وهو رسم المسار المعقّد للسردية العربية تكوينا وبنية في أثناء هذه الحقبة الطويلة، وتبيّن لي، وأنا أتولّى تدريس القديمة منها والحديثة لأكثر من عقد في عدد من الجامعات العربية في المشرق والمغرب، وأمارس البحث والكتابة في هذا المجال لنحو عشرين سنة، غياب الوعي بمسارها، فالمعلومات الشائعة إنما هي نبذ متناثرة، وتاريخية الطابع، ولا تهدف إلى ربط النصوص ببعضها ببعض، ولا تستنطق أبنيتها الدلالية، ولا تعنى بأصولها الشفوية، وعلاقتها بالنصوص الدينية.
وإذا كان القارئ العربي أنتج وعيا مختزلا بمسار الشعر العربي، بسبب الطريقة الخطية العتيقة التي سارت عليها كتب تاريخ الأدب، فقد حُرم، بصورة عامة، من معرفة السرديات العربية التي قامت بتمثيل المخيال العربي-الإسلامي، واختزنت رمزيا كل التطلّعات الكامنة فيه، والتجارب العميقة التي عرفها، وتخيلها. وتعرّضت، طوال أكثر من ألف وخمسمئة سنة، إلى سوء فهم، نتيجة التركيز على الشعر، من جهة أولى، وعدم امتثال معظم المرويات السردية القديمة لشروط الفصاحة المدرسية التي أنتجتها البلاغة العربية في العصور المتأخرة، تلك الشروط المعيارية التي أصبحت تحدّد قيمة الأدب، من جهة ثانية، وبسبب عدم اعتراف الثقافة المتعالمة بقيمتها التمثيلية سواء أكان ذلك عند القدماء أم عند المحدثين، إلا في حدود ضيقة، وذلك حينما تشكّلت الأنواع السردية القديمة، وحينما انبثقت الأنواع الجديدة من خضمّ التراث السردي المتحلّل الذي يعدّ رصيدها الأول، من جهة ثالثة. وبالإجمال فالسرديات العربية اختُزلت إما إلى وقائع تاريخية وإخبارية أو إلى أباطيل مُفسدة.
ويدرك كلّ من قيض له العمل في مجال الدراسات السردية، في الجامعات وسواها، الجهل شبه التام بالخلفيات الشفوية والدينية للمرويات السردية، والجهل بالعلاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي إلى أنواع مختلفة، والجهل بأبنيتها السردية والدلالية، والجهل بوظائفها التمثيلية، فكأن وعينا بأدبنا ناقص، وكأن تاريخ الأدب العربي يقفز على رجل واحدة. ولا يمكن الادّعاء بأن هذه الموسوعة ستجعله يسير على رجلين، فذلك أمر يتجاوز قدرتها، ويفوق طموحها، إنما تريد المساهمة في تنشيط الاهتمام بهذا الجانب، كونها وقفت على الأنواع السردية الأساسية، وتشكّلاتها، ضمن السياقات الثقافية الحاضنة لها، ولم تعن بالنصوص المتفرّقة التي لم تندرج ضمن الأنواع الكبرى، إلا في كونها أصولا لها أو تشقّقات عنها، فذلك مطمح كبير لم تتوفر عليه. ومعالجة النصوص السردية بطرائق منهجية حديثة لم تظهر في الثقافة العربية الحديثة إلاّ في الربع الأخير من القرن العشرين، والمحاولات القليلة السابقة كانت بدايات مهجّنة من دراسات متعدّدة في مناهجها ومرجعياتها، إلى ذلك فالاهتمام بتحليل السرد العربي القديم كان نادرا، ولم يبعث إلاّ فيما بعد، وما زالت تلك المادة الخام بأمسّ الحاجة إلى فحص نقدي عميق، يستخرج سماتها الأسلوبية، والبنائية، والدلالية، وذلك لا يتأتى إلاّ بجهد جماعي يلفت الانتباه إلى هذه الذخائر المطمورة في الأدب القديم.
يعرف المعنيون بهذا الموضوع صعاب التوغل في ذلك العالم شبه المجهول، المترامي الأطراف، الذي لم يُستكشف منه سوى جزء صغير، لأسباب ثقافية ودينيّة، ويعرفون القضية الأكثر خطورة وحساسية؛ وهي: العلاقات المتشابكة بين نشأة المرويات السردية، ونشأة النصوص الدينية، ونشأة الأخبار والتواريخ، وقصص الأنبياء والإسرائيليات، إلى حدٍّ أصبح فيه تخليص المرويات السردية من كل ذلك أمرا مستحيلا؛ إذ كانت العناصر المذكورة، بأطرها الثقافية الكلية، الحاضنة التي تشكّلت في وسطها تلك المرويات، فصاغت خصائصها الفنية صوغا شبه تام، وهذا هو السبب الذي دفعنا الى معالجة المرويات السردية ضمن السياقات الثقافية التي تكوّنت فيها. والأمر الآخر الذي يلاحظه كل متفحّص هو: الخصائص الشفوية للمرويات السردية، وذلك يعود إلى أنها ظهرت في أوساط شفوية يقوم الإرسال والتلقّي فيها على أسس متصلة بسيادة التفكير الشفوي، واسـتند ذلك التفكير إلى أصول دينية، فالشفاهية انتزعت شرعيتها في الفكر القديم بناء على أصول دينية، ومن هنا أصبحت ممارسة مبجّلة؛ لأنها عمّمت أسلوب الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على مجالات أخرى لا صلة لها بالدين. وبذلك أصبح الإسناد ركنا أساسا لا يمكن تجاوزه في المرويات السردية. وكان الإسناد يعامل دائما في الثقافة العربية القديمة، وبخاصة الدينية، على أنه جزء من الدين، انتقلت القداسة إليه بفعل المجاورة، مجاورته لمتون الحديث النبوي، كونه حاملاً لتلك النصوص المقدسة. وكما أن الصلة قوية ومتماسكة وضرورية بين السند والمتن، فقد تجلّت، بالصورة نفسها، في المرويات السردية بين الراوي والمروي، وهذا النسق لا يظهر الاّ في الثقافات الشفاهية، وقام التدوين بدور الوسيلة التي ثبّتت ذلك النسق وقيّدته، دون أن تخلخل العلاقة بين ركنيه الأساسيين المذكورين، إلى ذلك فالشفاهية هي التي منحت المرويات القديمة هويتها المميزة، وربط تلك المرويات بأصولها، والمؤثرات الفاعلة في تكوينها، لا يمثل أي خفض لقيمتها الأدبية أو التاريخية، إنما يصف واقع حالها.
ينتمي السرد العربي القديم إلى السرود الشفوية، فقد نشأ في ظل سيادة مطلقة للمشافهة، ولم يقم التدوين، الذي عرف في وقت لاحق لظهور المرويات السردية، إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي، ولم تكن الشفاهية نظاما طارئا بل كانت محضنا نشأت فيه كثير من مكونات الثقافة العربية في مظاهرها الدينية والتاريخية والأدبية واللغوية، فقداستمدت الشفاهية قوتها المعرفية من الأصول الدينية التي وجهتها توجيها خاصا، بما يجعلها تندرج في خدمة الدين، رؤية وممارسة. وتتحدّر المرويات السردية عن جذور شفوية، فهي"فن لفظي"(1) يعتمد على الأقوال الصادرة عن راو، يرسلها إلى متلقٍّ، ولهذا السبب كانت الشفاهية موجِّها رئيسا في إضفاء السمات الشفوية على الملاحم، والحكايات الخرافية والأسطورية، وجرى تمييز بين السرود الشفوية والسرود الكتابية، ولم يخضع التمييز لعامل الزمن كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيد، والثانية إلى العصر الحديث، إنما وضعت في الحسبان الخواص الفنية المميزة للبنى السردية في كل منهما، إذ اتصفت المرويات السردية الشفوية بأنها تتألف من"الراوي وحكايته والمتلقّي الضمني" أما السرود الكتابية، فإنها تتألف من"تمثيل" لكل من" الراوي وحكايته والمتلقّي الضمني"(2).
يقرن هذا التمييز السرود الشفوية بالبروز الكامل للمكونات السردية التي تكوّنها بما يجعل كل مكون عنصرا قائما ظاهرا؛ ذلك أن المرويات الشفوية لا توجد إلا بحضور جليّ لراو، ومرويّ له، ولا يمكن تغييب أي مكوّن، الأمر الذي يقرر أن تلك المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي الذي كان مهيمنا زمنا طويلا في البنية الذهنية للمجتمعات البشرية، كما أن ذلك التمييز، يحجب عن السرود الكتابية، صفة إشهار مكونات البنية السردية، وبها يستبدل نوعا من"التمثيل" لتلك المكونات، ولكنه لا يلغيها. وفيما يمكن القول بأن المرويات الشفوية تضع "مسافة" واضحة بين مكونات البنية السردية، فالراوي غالبا ما يكون متعينا، سواء بسماته أم بالمسافة التي تفصله زمانيا عما يروي، بحيث يروي أحداثا لا تعاصره، وقد لا ترتبط به إلا لكونه راويا لها فحسب، ونصطلح على هذا الراوي بـ" الراوي المفارق لمرويّه" لأنه يروي متونا لا تنتسب إليه، فإنّ تجليات" الراوي المتماهي بمرويه " تظهر بصورة أكثر في السرود الكتابية، وفي هذه السرود تغيب" المسافة" بين مكونات البنية السردية، وغالبا ما تختفي وراء" ضمير" يحيل على شخص مجهول، لا يعلن عن حضوره، ويتجنب الإشارة إلى نفسه، ويؤدي وظيفته في تشكيل المروي بوصفه جزءا منه، ولا يعنى بتوجيه خطابه مباشرة إلى مروي له ذي ملامح متعينة، وبذلك تكاد تتوارى الخصائص الشفوية، ويصبح الخطاب السردي وحدة كلية متجانسة، تتطلب تدقيقا وتفحصا من أجل كشف مكونات البنية السردية، ذلك أن الكتابة، على نقيض المشافهة، لا تستدعي انفصالا بين المؤلف والخطاب، شأن المشافهة التي تلزم ضرورة الانفصال بين الراوي والمروي؛ لأنها تستعين بالصوت المسموع وسيلة لها، فيما تعتمد الكتابة على الحرف أداة لصوغ الخطاب السردي. أفضى هذا التفريق إلى وصف السرود الشفوية بـ"العرضية" ووصف السرود الكتابية بـ" الدائمة"(3) لأن الأولى تتغير بتغير الرواة وعصورهم، فيما تظل الثانية خالدة، يمكن إعادة إنتاجها وتأويلها في أزمنة وأمكنة مختلفة، فضلا عن قدرة السرود الكتابية على الاندراج في سياق قراءات وتأويلات جديدة، كلما تغير الزمن، مع احتفاظها بالأصل الذي ظهرت فيه، فيما لا تتصف المرويات الشفوية بسمة الثبات والبقاء، الأمر الذي يعرّضها للتغيير والتزييف والفناء، بمرور الزمن.
2. السردية: حدود المفهوم
تُعنى السردية باستنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية، واستخراج النُظم التي تحكمها وتوجّه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها(4)، ووُصِفتْ بأنها "نظام نظري، غُذّي، وخصّب، بالبحث التجريبي"(5).وهي تبحث في مكونات البنية السردية للخطاب من راو ومروي ومروي له، ولما كانت بنية الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات، أمكن التأكيد على أن السردية،هي: المبحث النقدي الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي، أسلوبا وبناء ودلالة. والعناية الكلية بأوجه الخطاب السردي، أفضت إلى بروز تيارين رئيسين في السردية، أولهما: السردية الدلالية التي تعنى بمضمون الأفعال السردية، دونما اهتمام بالسرد الذي يكوّنها، إنما بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك الأفعال، ويمثل هذا التيار: بروب، وبريمون، وغريماس. وثانيهما: السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب، وما ينطوي عليه من رواة، وأساليب سرد، ورؤى، وعلاقات تربط الراوي بالمروي. ويمثل هذا التيار، عدد من الباحثين، من بينهم: بارت، وتودروف، وجنيت. وشهد تاريخ السردية محاولة للتوفيق بين منطلقات هذين التيارين، إذ سعى جاتمان وبرنس إلى الإفادة من معطيات السردية في تياريها: الدلالي واللساني، والعمل على دراسة الخطاب السردي بصورته الكلية، وفيما اتجه اهتمام برنس إلى مفهوم التلقّي الداخلي في البنية السردية، من خلال عنايته بمكوّن المروي له، اتجه اهتمام جاتمان إلى البنية السردية عامة، فدرس السرد بوصفه وسيلة لإنتاج الأفعال السردية، وبحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من الحوادث والوقائع والشخصيات التي تنطوي على معنى.وعدّ السرد نوعا من وسائل التعبير، في حين عدّ المروي محتوى ذلك التعبير، ودرسهما بوصفهما مظهرين متلازمين من المظاهر التي لا يتكوّن أي خطاب سردي من دونهما(6).
اشتقّ تودروف، في عام 1969، مصطلح Narratology بيد أنّ الباحث الذي استقامت على جهوده السردية في تيارها الدلالي، هو الروسي بروب(1895-1970) الذي بحث في أنظمة التشكّل الداخلي للخرافة الروسية حينما خصّها ببحث مفصّل انصب اهتمامه فيه على دراسة الأشكال والقوانين التي توجه بنية الحكاية الخرافية (7)، فأقرّ الباحثون اللاحقون في حقل السردية ريادته المنهجية والتاريخية في هذا المجال( . وسرعان ما أصبح بحثه في البنية الصرفية للخرافة الروسية موجّها أساسا لعدد كبير من الباحثين، أطلق عليهم شولز"ذرية بروب"(9)، كغريماس، وبريمون، وتودروف، وجنيت. وعملت"ذرية بروب"على توسيع حدود السردية، لتشمل مظاهر الخطاب السردي كلها، واتجهت بحوثهم اتجاهين، أولهما" السردية الحصرية" وهدفت إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامة أنظمة دقيقة تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانيهما "السردية التوسيعية" وتطلّعت إلى إنتاج هياكل عامة، توجّه عمل مكونات البنية السردية، لتوليد نماذج شبه متماثلة، على غرار نماذج التوليد اللغوي في اللسانيات. واقتصر اهتمام السردية، أول الأمر، على موضوع الحكاية الخرافية والأسطورية، واستنباط الخصائص المميزة للبطل الأسطوري، ثم تعدّدت اهتمامات السرديين، لتشمل الأنواع السردية الحديثة كالرواية والقصة القصيرة، فظهر عدد من الباحثين في هذا الشأن أولوا تلك الأنواع جلّ اهتمامهم، مثل: باختين، وأوسبنسكي، وأُمبرتو إيكو، وجوليا كرستيفا، وفردمان، وشولز، وفاولر، وغيرهم، وخصّبت دراساتهم جميعا هذا المبحث النقدي الجديد، ووسّعت آفاقه، وبصدوركتاب جيرار جنيت"خطاب السرد"في عام 1972، اعتُرف بالسردية بوصفها مبحثا متخصّصا في دراسة المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة، وفي هذا الكتاب جرى تثبيت مفهوم السرد، وتنظيم حدود السردية(10).
. وسرعان ما أصبح بحثه في البنية الصرفية للخرافة الروسية موجّها أساسا لعدد كبير من الباحثين، أطلق عليهم شولز"ذرية بروب"(9)، كغريماس، وبريمون، وتودروف، وجنيت. وعملت"ذرية بروب"على توسيع حدود السردية، لتشمل مظاهر الخطاب السردي كلها، واتجهت بحوثهم اتجاهين، أولهما" السردية الحصرية" وهدفت إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامة أنظمة دقيقة تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانيهما "السردية التوسيعية" وتطلّعت إلى إنتاج هياكل عامة، توجّه عمل مكونات البنية السردية، لتوليد نماذج شبه متماثلة، على غرار نماذج التوليد اللغوي في اللسانيات. واقتصر اهتمام السردية، أول الأمر، على موضوع الحكاية الخرافية والأسطورية، واستنباط الخصائص المميزة للبطل الأسطوري، ثم تعدّدت اهتمامات السرديين، لتشمل الأنواع السردية الحديثة كالرواية والقصة القصيرة، فظهر عدد من الباحثين في هذا الشأن أولوا تلك الأنواع جلّ اهتمامهم، مثل: باختين، وأوسبنسكي، وأُمبرتو إيكو، وجوليا كرستيفا، وفردمان، وشولز، وفاولر، وغيرهم، وخصّبت دراساتهم جميعا هذا المبحث النقدي الجديد، ووسّعت آفاقه، وبصدوركتاب جيرار جنيت"خطاب السرد"في عام 1972، اعتُرف بالسردية بوصفها مبحثا متخصّصا في دراسة المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة، وفي هذا الكتاب جرى تثبيت مفهوم السرد، وتنظيم حدود السردية(10).
تتشكّل البنية السردية للخطاب، من تضافر ثلاثة مكونات: الراوي، والمروي، والمروي له. يُعرف الراوي، بأنه ذلك الشخص الذي يروي الحكاية، أو يُخبر عنها، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة"(11) ولا يشترط أن يكون اسما متعيّنا، فقد يتوارى خلف صوت، أو ضمير، يصوغ بوساطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع، وجرت العناية برؤيته تجاه العالم المتخيّل الذي يكوّنه السرد، وموقفه منه، واستأثر بعناية كبيرة في الدراسات السردية. أما المروي فهو كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث يقترن بأشخاص، ويؤطّره فضاء من الزمان والمكان، وتعدُّ "الحكاية" جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله، وفُرّق بين مستويين في المروي، الأول "متوالية من الأحداث المروية، بما تتضمنه من ارتجاعات واستباقات وحذف" واصطلح الشكلانيون الروس على هذا المستوى بـ"المبنى". والثاني" الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث" واصطلحوا عليه بـ"المتن"(12). المبنى يحيل على الانتظام الخطابي للأحداث في سياق البنية السردية، أما المتن فيحيل على المادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث، في سياقها التاريخي(13).
اتسع مجال البحث حول المبنى والمتن بوصفهما وجهي المروي المتلازمين، إذ ميز جاتمان بين "القصة" وهي سلسلة الأحداث، وما تنطوي عليه من أفعال ووقائع وشخصيات محكومة بزمان ومكان، و"الخطاب" وهو التعبير عن تلك الأحداث، وخلص إلى القول" إن القصة هي محتوى التعبير السردي، أما الخطاب فهو شكل ذلك التعبير"(14). والفرق بين المحتوى وكيفية التعبير عنه، فرق كبير، فالأول يحيل على المتن، فيما يحيل الثاني على المبنى. أما المروي له، فهو الذي يتلقّى ما يرسله الراوي، سواء أكان اسما متعينا ضمن البنية السردية، أم شخصا مجهولا. ويرى برنس" أن السرود، سواء أكانت شفوية أم مكتوبة، وسواء أكانت تسجل أحداثا حقيقية أم أسطورية، وسواء أخبرت عن حكاية أم أوردت متوالية بسيطة من الأحداث في زمن ما، فإنها لا تستدعي راويا، فحسب، بل مرويا له أيضا. والمروي له شخص يوجّه إليه الراوي خطابه، وفي السرود الخيالية – كالحكاية، والملحمة، والرواية - يكون الراوي كائنا متخيلا، شأن المروي له "(15). الاهتمام بالمروي له جعل البحث في البنية السردية أكثر موضوعية من ذي قبل، ذلك أن أركان الإرسال الأساسية، من راو ومروي ومروي له، استُكملت، مما سهّل فعالية الإبلاغ السردي، الذي هو الحافز الكامن خلف الأثر السردي. وتكشف أية نظرة إلى العلاقات التي تربط الراوي بالمروي وبالمروي له أن كل مكوّن لا تتحدّد أهميته بذاته، إنما بعلاقته بالمكونين الآخرين، وأن كل مكوّن سيفتقر إلى أي دور في البنية السردية، إن لم يندرج في علاقة عضوية وحيوية معهما، كما أن غياب مكوّن ما أو ضموره، لا يخلّ بأمر الإرسال والإبلاغ والتلقّي، فقط، بل يقوض البنية السردية للخطاب، ولذلك، فالتضافر بين تلك المكونات، ضرورة ملزمة في أي خطاب سردي
ليست السردية نموذجا تحليليا جامدا ينبغي فرضه على النصوص، إنما هي وسيلة للاستكشاف العميق المرتهن بقدرات الناقد، ومدى استجابة النصوص لوسائله الوصفية، والتحليلية، والتأويلية، ولرؤيته النقدية التي يصدر عنها، فالتحليل الذي يفضي إليه التصنيف والوصف، متصل برؤية الناقد، وأدواته، وإمكانياته في استخلاص القيم والسمات الفنية الكامنة في النصوص. وبما أن الدقة لا تتعارض مع كلية التحليل وشموليته، فالحاجة تفرض على السردية الانفتاح على العلوم الإنسانية والتفاعل معها، لأن كشوفاتها تغذّي السردية في إضاءة مرجعيات النصوص الثقافية والدينية، بما يكون مفيدا في مجال التأويل وإنتاج الدلالات النصية، ويمكن استثمارها في تصنيف تلك المرجعيّات، ثم كشف قدرة النصوص على تمثيلها سرديا، إلى ذلك يمكن أن توظّف في المقارنات العامة، ودراسة الخلفيات الثقافية كمحاضن للنصوص، ومن المؤكد أن ذلك يسهم في إضفاء العمق والشمولية على التحليل النقدي، بما يفيد السردية التي يظل رهانها متصلا برهان المعرفة الجديدة.
وشأنها شأن أي مبحث جديد، قوبلت السردية، في الثقافة العربية الحديثة، بالترحاب والمقاومة معا، ومرت مدة طويلة قبل أن تتخطّى الصعاب، وتنتزع الشرعية في بعض الأوساط الثقافية والأكاديمية، وإذا عدنا إلى السياق الثقافي الذي عُرفت فيه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، نجد انشطارا في المواقف كان قد تبلور حولها، فمن جهة أولى ضربت السردية الدراسات القديمة في الصميم، حينما نقلت النقد من الانطباعات الشخصية العابرة، والتعليقات الخارجية، والأحكام الجاهزة إلى تحليل الأبنية السردية، والأساليب، والأنظمة الدلالية، ثم تركيب النتائج في ضوء تصنيف دقيق، ومعمّق لمكونات النصوص السردية، وبذلك قدّمت قراءة مغايرة للنصوص السردية، ومن جهة ثانية، حامت شكوك جديّة حول قدرة السردية على تحقيق وعودها، لأن كثيرا من الدراسات السردية وقعت أسيرة الإبهام، والغموض، والتطبيق الحرفي للمقولات الجاهزة فيها، دون الأخذ بالحسبان السياقات المتفاوتة بين النصوص، والاختلاف في استخدام المفاهيم، ممّا أوقد شكّاً في القيمة العلمية للسردية، واحتاج الأمر جهدا كبيرا ينقّيها من الشوائب التي لحقت بها، ومن ذلك فقد طُرحت اجتهادات عدّة تهدف إلى تحقيق دلالة المصطلح النقدي الذي تستعين به، ولعل أبرز ما استأثر بالنقاش في هذا المجال، هو: مصطلح "السردية" الذي استخدمناه كمقابل لـ"Narratology"باعتباره المصطلح الأدق، والأكثر تعبيرا عن المفهوم، وجعلناه عنوانا لبحث الدكتوراه في عام 1988 إذ أوضحنا بأن المصدر الصناعي في العربية، يدل على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنه ينطوي على خاصية التسمية والوصف معا. فـ"السردية"بوصفها مصطلحا، تحيل على مجموعة الصفات المتعلّقة بالسرد، والأحوال الخاصة به، والتجليات التي تكون عليها مقولاته، وعلى ذلك فهو الأكثر دقة في التعبير عن طبيعة الاتجاه الجديد في البحث الذي يجعل مكونات الخطاب السردي وعناصره موضوعا له، كما أننا آثرنا الشكل البسيط للمصطلح، وسرعان ما شاع بسبب دقته وبساطته.
حيثما سيتردّد مصطلح" السردية العربية " في هذه الموسوعة، فلا يحيل على مقصد عرقي، إنما الهدف منه الوقوف على المرويات السردية القديمة، والنصوص السردية الحديثة، التي تكوّنت، أغراضا وبنى، ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة العربية، والتي كان التفكير والتعبير فيها يترتب بتوجيه من الخصائص الأسلوبية والتركيبية والدلالية لتلك اللغة، وكانت الشفاهية التي استندت إلى قوة دينية، جعلت اللغة العربية وسيلة التعبير الأساسية في ثقافة تتصل بها مباشرة، فهي لغة الخطاب الديني الذي ينطوي على تلك القوة، الأمر الذي مكّن اللغة العربية، بوساطة القوة الدينية، أن تمارس حضورها الثقافي في بلاد كثيرة، تستوطنها أعراق متعددة، قديما وحديثا، مما جعل مظاهر التعبير فيها تخضع لخصائص العربية وسماتها.
3. السرد: التلقّي والتواصل
ولا يمكن فهم أهمية السردية في تحليل النصوص إن لم تربط بنظرية"التلقّي" التي تعنى بتداول النصوص وتلقّيها، وإعادة إنتاج دلالاتها، سواء أكان ذلك في الوسط الثقافي الذي تظهر فيه، وهو ما نصطلح عليه بـ" التلقّي الخارجي" أم داخل العالم الفنّي التخيّلي للنصوص الأدبية ذاتها، وهو ما نصطلح عليه بـ" التلقّي الداخلي" ولا تكتسب نظرية التلقّي قيمتها المعرفية إلا إذا نُزلّت منزلتها الحقيقية، بوصفها نشاطاً فكرياً متصلاً بنظرية أكثر شمولاً هي نظرية" الاتصال" التي استفادت من البحث الفلسفي في مجال التواصل الذي يعتبر وسيلة التفاعل الأساسية بين الأفراد والجماعات، للتحكّم بالأنظمة المادية والرمزية، وبخاصة الآداب السردية، وهذا ما جذب اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكّر، وبخاصة فلاسفة مدرسة " فرانكفورت" الذين أفلحوا في تأسيس نظرية فلسفية نقدية، كان لها أكبر الأثر في تغذية الفكر الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعيين، وعلى يدي" هابرماز" استقام نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي تحوّل إلى "عقل أداتي" فطرح "هابرماز" مفهوم "العقل النقدي الاتصالي" الذي يرتبط بالحداثة فينتجها وتنتجه، معتبراً ذلك العقل الوسيلة التي تخرج بها الفلسفة من بعدها الذاتي الضيّق إلى أفقها الاجتماعي الواسع(16).
يصرّ "هابرماز" على أن هذا العقل قادر على الانخراط ضمن صيرورة الحياة الاجتماعية عبر التواصل، باعتبار أنّ أفعال الفهم المتبادل تلعب دور آليّة ترمي إلى تنسيق العمل، فالأعمال التواصلية تشكّل نسيجاً يتغذّى من موارد العالم المعيش، وتشكّل، نتيجة لذلك" الوسيط " الذي تعيد انطلاقاً منه أشكال الحياة العيانية إنتاج ذاتها(17). وإذا نظرنا إلى المؤثرات التي تركها الشكلانيون الروس، ومدرسة براغ، فضلاً عن " إنغاردن" و "غادامير"، ثم" ياوس" و" آيزر" في ظروف نشأة نظرية التلقّي، فإنها مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال، وكثيراً ما أشار روّاد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين الاثنين، بل ذهبوا إلى أنّ جهودهم تترتب ضمن أفق نظرية الاتصال، وهو ما أكده "ياوس" حينما قرّر أنّ نظرية التلقّي لا بد أن تبلغ مداها في نظرية أعم في الاتصال، لأن الاتجاهات النقدية الحديثة وضعت قضية الاتصال في صلب اهتمامها، فكل المحاولات التي تتبلور من أجل صياغة نظرية تلقّي الأدب، إنما هي متصلة بنظرية الاتصال، فالغاية من ذلك تقدير وظائف الإنتاج الأدبي والتلقي والتفاعل، وكل ما يتصل بذلك. ويشاركه في ذلك " آيزر" الذي يشتغل على مفاهيم البنية والوظيفة والاتصال، وجهوده قائمة على تنظيم صيغة التفاعل بين النص والقارئ، من أجل سريان الفاعلية بينهما، فهو يفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط مشترك بين القارئ والنص، بحيث يؤثّر أحدهما في الآخر من خلال عملية تنظيم تلقائية(18).
تعدّ نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي أثْرَتْ السردية. وكان الاهتمام بالتواصل الخارجي بين النصوص الأدبية والمتلقّين مثار عناية رواد نظرية التلقّي، وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين اللاحقين، لتنقل الاهتمام من التلقّي الخارجي إلى التلقّي الداخلي، الذي يُعنى بفحص طبيعة التراسل الداخلي في النصوص الأدبية، والسردية منها على وجه خاص، واندمج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة التي بلورتها الدراسات السردية التي تعمّقت في وصف مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها وأنظمتها الدلالية، وبُذلت جهود كبيرة في معاينة التلقّي الداخلي استنادا إلى فرضية أساسية، وهي: أنّ الإرسال السردي داخل النصوص لا بدّ أن يتم بين "الراوي" باعتباره قطب الإرسال، و"المروي له" بوصفه قطب التلقّي، فالمادة السردية إنما هي مداولة قوامها الإرسال والتلقّي، ولا ينبغي فهم دور" المروي له" على أنه دور من يتلقّى فقط، وينفعل بما يُرسل إليه، فوظائفه أكثر من ذلك، وقد حدّدها برنس، بأنها: تتصل بنوع التوسط بين الراوي والقارئ، وفي الكيفية التي يسهم فيها بتأسيس هيكل السرد، وتحديد سمات الراوي، وكشف مغزى النص، وتنمية حبكة الأثر الأدبي، وتحديد مقاصده(19). وكان جاتمان قد حدّد مستويات عدة للإرسال والتلقّي، تبعاً لنوع العلاقة التي تربط المرسل بالمتلقّي، فتوصّل إلى ضبط المستويات الآتية:
1. مستوى يحيل على مؤلف حقيقي، يُعزى إليه الأثر الأدبي، يقابله قارئ حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر.
2. مستوى يحيل على مؤلف ضمني، يجرّده المؤلف الحقيقي من نفسه، يقابله قارئ ضمني يتجه إلى الخطاب.
3. مستوى يحيل على راوٍ ينتج المروي، يقابله مروي له يتجه إليه الراوي.
ويرى جاتمان أنّ " النص السردي" يكون نتاجاً للمستويين الثاني والثالث، فإليهما تعود مهمة إنتاج الأثر السردي المجرّد قبل أن تغذّيه القراءة بإمكانات التأويل(20). وذهب جوناثان كلر المذهب ذاته، لكنه اشتقّ أربعة مستويات للتلقّي في النصوص السردية: مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارئ بالمعنى العام والخاص لكلّ منهما، ومستويان داخليان متصلان بالراوي والمروي له، سواء أكان ذلك متعلقاً بالراوي والمروي له بوصفهما مرسلاً ومتلقيّاً، أم بالمتلقّي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي، وليس الاقتصار على تلقيها(21). والوظيفة الأخيرة المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقي الداخلي. تقوم المكونات النصية الداخلية، وبخاصة الراوي والمروي له بتشكيل النسيج الدلالي والتركيبي للنصوص الأدبية، باعتباره فعالية تراسليّة تقوم على البث والتقبّل، والإرسال والتلقّي، وبذلك تتكوّن الأبعاد الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى إخراجها، ثم إعادة إنتاجها في ضوء البنية الثقافية الخارجية، حيث تكون خاضعة للوصف، والتحليل، والتفسير، والاستنطاق، والتأويل.
ويُدخل أمبرتو إيكو القارئ طرفاً أساساً في عملية خلق العوالم الافتراضية الممكنة للنصوص السردية إلى جوار المؤلف، لأنه يُدرج الأدب ضمن نظرية الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين، أحدهما يركّب رسالة ويقوم بإرسالها، والآخر يتلقّاها ويقوم بفكّ شفراتها، وإعادة بنائها بصورة عالم متخيّل، مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها النصية. والنص إنْ هو إلاّ نتاج يرتبط مصيره التأويلي أو التعبيري بآلية تكوينه ارتباطاً لازماً ؛ فأن يكوّن المؤلف نصاً يعني أن يضع حيّز الفعل استراتيجية ناجزة تأخذ في الحسبان توقّعات حركة المتلقي، شأن كل استراتيجية. وبعبارة أخرى فالنص نتاج لعبة نحوية –تركيبية-دلالية- تداولية، يشكّل تأويلها المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني الخاص، ولهذا يصبح الحديث عن عالم ممكن للنص ضرورياً، من أجل إثبات صحة الحديث حول توقّعات القارئ، الذي يقوم من عبر التلقّي بتنشيط المكونات السردية المتداخلة، بما في ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزماني- المكاني الذي يحتويهما، وذلك داخل سياق معين. وفي ضوء هذا التصور يعالج إيكو العوالم الافتراضية الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية في إشارة للصلات المحتملة بين العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية، فيقول " إنّ أي عالم حكائي لا يسعه أن يكون مستقلاً استقلالاً ناجزاً عن العالم الواقعي" بل إنهما يتداخلان ويأخذان المعنى الخاص بكلٍّ منهما من الخزين الثقافي للمتلقّي، لأنّ الواقع نفسه بنيان ثقافي، ويصبح أمر التراكب بينهما ممكناً وذلك بتحويلهما إلى كيانات متجانسة، وهنا تتبدّى الضرورة المنهجية لمعالجة العالم الواقعي باعتباره بنياناً، وكلما عمدنا إلى مقارنة سياقية ممكنة من الأحداث والأشياء كما هي، فإننا نتمثّل الأشياء كما هي، تحت شكل بنيان ثقافي، محدود، ومؤقت ومناسب. ولهذا يحدّد إيكو الأشكال التي يمكن أن تتخذها المقارنة بين العالمين:
1. يتسنّى للمتلقّي أن يقارن العالم المرجعي بحالات من الحكاية مختلفة، محاولاً أن يدرك إذا كان ما يجري يستجيب لمعايير الممكن الوقوع. وفي هذه الحالة، يقبل المتلقّي الحالات قيد المعالجة باعتبارها عوالم ممكنة.
2. يمكن للمتلقّي أن يقارن عالماً نصياً بعوالم مرجعية مختلفة، وذلك استناداً إلى نوع من المماثلة الممكنة بين أحداث العالمين، وقابلية حصولها، ويصار في هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناءً على نوع المخزون الثقافي لدى القارئ، ومدى خضوعه لنسق ثقافي يمكنه من التصديق أو التكذيب، فقارئ القرون الوسطى المشبّع بقيم الثقافة السائدة آنذاك يمكن أن يتلقّى الأحداث المرويّة في "الكوميديا الإلهية" على أنها ممكنة الوقوع، إلاّ أنّ قارئاً حديثاً يعتبر تلك الأحداث غير ممكنة الوقوع.
3. قد يتاح للمتلقّي أن يبني عوالم مرجعية مختلفة، أيّ منوّعة عن العالم الواقعي، وذلك حسب النوع الأدبي المعيّن، فالرواية التاريخية، على سبيل المثال، تتطلّب الرجوع إلى الخزين التاريخي، فيما تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب المشتركة. وهكذا يصار إلى التوفيق بين العالمين(22).
عرّف" فان ديك" السرد بأنه: وصف أفعال، يلتمس فيه لكلّ موصوف فاعلاً وقصداً وحالة وعالماً ممكناً وتبدلاً وغاية، فضلاً عن الحالات الذهنية والشعورية والظروف المتصلة بها، فالتنافد قائم بين عمليتي الإرسال والتلقّي، لأن السلسلة اللفظية المشفّرة التي يرسلها المؤلف، يقوم المتلقّي بحلّها في ضوء السياق الثقافي، وبذلك يشكّل عالماً خيالياً، يستمد دلالته من المضمرات النصيّة التي تستثار بعلاقاتها المختلفة بالمرجع، كما ذهب إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية يعتبر تتويجاً لدراسات تبدأ بالسياق التداولي، فالسياق المعرفي، ثم السياق الاجتماعي- النفسي، وأخيراً السياق الاجتماعي- الثقافي، وربط كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعملية فهمه، وتأثيره، وأخيراً تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعية، إذ يحدّد السياق الاجتماعي نوع الخصوصيات التي يمكن أن تطبع النصوص، والأنماط الشائعة منها، وقدرتها في الإحالة على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل بين النص والسياق الاجتماعي- الثقافي لا يحدد فحسب القواعد والمعايير الضرورية، إنما مضمون النصوص ووظائفها، وذلك ضمن أطر واضحة، ويعزو اختلاف الظواهر الثقافية، وشيوع أنواع من النصوص، بما في ذلك البنيات النسقية والأسلوبية والبلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل ونوعه وشروطه وعصره(23).
يتمّ التراسل بين المرجعيات بكل مكوناتها والنصوص على وفق ضروب كثيرة ومعقدة من التفاعل، فليس المرجعيات وحدها تصوغ الخصائص النوعية للنصوص، بل إنّ تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيات، وتسهم في إشاعة أنواع أدبية معينة وقبولها، ويظلّ هذا التفاعل مطّرداً، وسط منظومة اتصالية شاملة تسهل أمر التراسل بينهما، بما يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات والنصوص وأساليبها وموضوعاتها، وهي أنساق وأبنية سرعان ما تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعية والأدبية فيحصل انفصال بين هذه النماذج التجريدية من الأنساق، ودينامية الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك، قبل أن يعاد تشكيل العلاقات وفق أنساق جديدة.
4. موقع نظرية الأنواع الأدبية
ويحرص هذا التمهيد على إثارة قضية أخرى متصلة بالأنواع السردية القديمة التي سنقوم بدراستها بالتفصيل في هذه الموسوعة، وتلك القضية هي موقع" نظرية الأنواع الأدبية" في الأدب العربي، والحق فالنقد وتاريخ الأدب يكشفان ضآلة العناية بهذا الموضوع، بل إنهما يكشفان حالة متوترة من عدم الاتفاق بين مؤرخي الأدب والنقاد في كل ما يخص هذه القضية الشائكة، ويعود ذلك إلى الإخفاق في التفاهم حول مجموعة ثابتة من الشروط والقواعد التي يمكن الاهتداء بها لصياغة نتائج مقبولة وشبه نهائية، والبحث في موضوع "الأنواع الأدبية" والصعوبات الجمّة التي تعترضه، لا تقتصر على الأدب العربي، إنما يمثل مشكلة مزمنة في تاريخ الآداب العالمية، فمنذ أرسطو يثار دائما موضوع البحث في هذه القضية، وتستجد آراء وكشوفات، وفي ضوء ذلك يعاد ربط كثير من أشكال التعبير الأدبي بأصول مهملة، أو يصار إلى توسيع مفهوم "الجنس" أو "النوع" أو"النمط" أو"الشكل"، ومثل ذلك نجده عند"باختين "في ربطه الرواية بمظاهر التعبير الكرنفالية(24) فيما كان الشائع أنها سليلة الملحمة. وعند"جنيت" في توسيع مفهوم النوع، وإعادة دمج الأنواع والأشكال ببعضها ببعض، وإحداث تفريعات وتطويرات في التصورات الموروثة حول ذلك منذ أرسطو، وبلورتها ضمن إطار مفهوم "جامع النص"(25).
حاول البحث في هذا الموضوع، ضمن دائرة الثقافة العربية، التوفيق بين رسم تاريخ ظهور الأنواع الأدبية من جهة، والخصائص الفنية لتلك الأنواع من جهة ثانية، ومن الطبيعي أن يفضي بحث ينطلق من هذا التصور إلى الخلط بين التاريخي والنقدي، الأمر الذي لا يوفر في غالب الأحيان إمكانات لأي نجاح متوقع. ظهر هذا الخلط حينما اتخذ البحث طابع المفاضلة بين الشعر والنثر، ولم تستأثر قضية أسباب ظهور الآداب إلا بإشارات عابرة، في سياق مجادلات لم تعن بالهدف الجوهري الخاص بالتمايز النوعي بين النصوص، ولا البحث المقارن بين التطورات الأسلوبية والبنيوية للنصوص السردية والشعرية، وخلال كل هذا ظهرت لمحات عابرة عن النثر، بصورة عامة، وليس عن السرد. ويمكن إجمال كل ذلك بظهور قولين، الأول يقول بالتوقيف الإلهي الذي نادى به الباقلاني(403=1012) ومؤدّاه أن الله أوقف قول كل شيء على لسان البشر فلا دور لهم في ظهور شيء منه(26)، والثاني القول بالمواضعة والاصطلاح(27)الذي أخذ به ابن رشيق القيرواني(453=1061) بعد أن أثاره النهشلي(28) وفيه ألتُفتَ إلى البعد التاريخي الخاص بالآداب، وبأنها أشكال لغوية تواضع عليها البشر، واتفقوا على ضرورتها، فأخذوا بها للتعبير عن أنفسهم وعالمهم.
لم تندرج هذه الأقوال في سياق تصور تاريخي- نظري دقيق يؤرخ لتطورات الأدب العربي، وأجناسه الكبرى الشعرية والنثرية، إنما ظلت أقوال متناثرة في المظان القديمة، ومن ذلك أشار بعض القدماء إلى أسبقية ظهور الشعر، منهم: أبو عمرو بن العلاء (145=752) والأصمعي(215=730) وابن سلام الجمحي(232=846) والجاحظ(255=869) وغيرهم(29). وتبع هذا أن وردت إشارات أخرى حول خصائص الشعر، وتباينت وجهات النظر بين مجموعة من النقاد مثل ابن طباطبا (322=934) وقدامة بن جعفر(326=938)- على سبيل المثال-وهما يعتبران الشعر كلاما موزونا ومقفى وله معنى(30).ومجموعة من الفلاسفة كالفارابي(355=950)وابن سينا(428=1037) وابن رشد(595=1198)الذين يضيفون أنه كلام مخيل قوامه الأقاويل الشعرية(31). القضية الأساسية التي يمكن الإشارة إليها هنا، هي أنه لم يبذل جهد يذكر في دراسة الخصائص الفنية للأنواع، ولا تواريخ ظهور أشكال تعبيرية كثيرة انفصلت عن تلك الأنواع الكبرى، وكوّنت داخل خارطة الأدب العربي مواقع خاصة لها، وهي أشكال شعرية ونثرية تزايد تكاثرها بمرور الوقت. وبخاصة بعد أن راحت الآداب القديمة تتشقّق إلى أشكال تخرج عن أنواعه الأساسية، وتزدهر في مناطق مختلفة، ويمكن اعتبارها أنواعا فرعية قبل أن تستقل، وتصبح أنواعا كاملة.
انتبه ابن خلدون(808=1406) إلى ظاهرة التشقّق هذه، وعزاها إلى أن لغة البلاد الجديدة، خارج شبه الجزيرة العربية، التي عدّت الموطن الأصلي للجذور الدلالية الفصيحة للغة العربية، اختلفت بعض الشيء، بسبب المؤثرات الثقافية، عن اللغة الأم (32). فاللغة علامة تداولية تتفاعل بتأثير من الطبيعة التراسلية بين المتعاملين بها، وبالنظر إلى اتساع دار الإسلام(= وهو المصطلح الشائع في أوساط القدماء، طوال العصور الإسلامية الوسيطة) فقد ضمت بين أطرافها مواطن حضارية لها ثقافات مختلفة، سواء أكان ذلك في العراق أم سوريا أم شمال أفريقيا أم الأندلس أم فارس وما خلفها، وتلك الثقافات لم تطمس، إنما تفاعلت مع الثقافة العربية، فأنتجت ثقافة، بل ثقافات، لها طوابع محلية، فهي متصلة بثقافة شبه الجزيرة، ومنفصلة في الوقت نفسه عنها. متصلة بها، لأن كثيرا من مظاهرها ترتّب في ضوء القواعد الأسلوبية والبنائية والدلالية للغة العربية الفصحى، التي كانت وسيلة التعبير المعتمدة للثقافة، ومنفصلة عنها، لأنها تستلهم التقاليد، والمرجعيات، والموروثات الشعبية للمجموعات العرقية التي طورت ضروبا متنوعة من الثقافات الخاصة داخل ذلك الإطار العام. ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التعبير في الثقافة السائدة بين هذه المنطقة وتلك، فلا يمكن تصور مماثلة كاملة بين صيغ تعبير تؤدي وظائف محددة للجميع، كما أن انبعاث الموروثات القديمة، واللغات، وبقايا العقائد، والتقاليد، واستمرارها أو تكيّفها، يقود لا محالة إلى تمايز في درجات التعبير وأشكاله، وهو أمر ينمّي مع مرور الزمن أشكالا أدبية جديد، وهذه الأشكال - وهي أكثر التصاقا بالبيئات الشعبية المحلية، سواء باستثمار الموضوعات الموجودة في تلك البيئات، أو الاستعانة باللهجات السائدة، أو الصيغ الأسلوبية المتداولة- تبتدع مسارات خاصة تخرج بها على أنماط التعبير الكبرى، فتنتهك القواعد التي رسختها مع الزمن تلك الأنماط. وهي لا توقّر، في الغالب، الثقافة الرسمية المتعالمة التي تحوّلت إلى قوالب جامدة، تفرض أطرها العامة كنوع من التقليد، دون أن تنتبه إلى خلوها من الحيوية والتجدّد.
الثقافة الرسمية السائدة تتواطأ مع السلطة، وتستخدم من قبل هذه الأخيرة في تسويغ أفعالها، فيما تطور الثقافات المحلية أشكالا مختلفة من الرفض وعدم القبول، وحيثما تتعدّد الانتماءات العرقية والدينية، تتنوع الثقافات، وتختلف الرؤى والتصوّرات، وحيثما تتجمّد الحياة في تضاعيف الثقافة العامة، وتخمد الاجتهادات، ويتعثّر التجديد، وتظهر قوالب فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقّفت عن العطاء الحقيقي، تنبعث دماء الابتكار والتجديد في ثنايا الثقافات المحلية الخاصة؛ فتتوازى ثقافتان: ثقافة تجريدية تقرّ بالثبات، وتبجّل الماضي، وتقدّس المقولات، وتضع بينها وبين موضوعاتها مسافة؛ لأن آلياتها تشتغل ضمن أطر وقوالب، لا تأخذ في الاعتبار حاجات التغير والتلقّي، وثقافة حسية، وتشخيصية، ومهجّنة، لا تقرّ بالثبات، ولا تؤمن بالصفاء، إنما تتكون من موارد عدة متداخلة ومتفاعلة لا تعزل نفسها عن العالم الذي تظهر فيه، إنما تنشغل به انشغالا مباشرا، وللتعبير عنه، لا تتردد في تهجين أساليب تعبيرية متعددة، ولا تخشى إثارة موضوعات مختلف حولها. إنها ثقافة انتهاكية وغير امتثالية غايتها التحوّل. وفيما تثبّت الثقافة الأولى الأشكال والأساليب التي أنتجتها في ذروة تطورها، تقوم الثقافة الأخرى باستحداث أشكال متجدّدة، وفيما تريد تلك إخضاع الحياة لأطرها الثابتة، تريد هذه أن تتوافق أشكال التعبير في اطراد متقدم مع تجدّد الحياة. هذه الاصطراعات العميقة كانت فاعلة في صلب الثقافة العربية-الإسلامية، وسنجد أن نسق التحولات يصطدم، بين فترة وأخرى، بالركائز الصماء للتقاليد التي تفرزها الثقافة الرسمية، وسيكون السرد، بتطوراته النوعية والأسلوبية، هو المحك المعبّر عن هذه التحولات.
5. الرؤية والمنهج
ولكن ما الصعاب التي تواجه البحوث الشاملة التي تعنى بالآثار المعرفية والإبداعية لأمة من الأمم، أو تلك التي تنتدب نفسها لدراسة ظواهر أدبية- ثقافية كبيرة؟ وكيف يمكن أن تدرس؟ تتركّز تلك الصعاب حول مجموعة من المحاور الأساسية المتداخلة، وهي: طبيعة المادة موضوع البحث، والرؤية التي يصدر عنها الباحث، والمنهج الذي يتبعه، والأهداف التي يتوخّاها من بحثه، ويقتضي بيان ذلك شيئا من التفصيل. الصعاب تكاد تكون متماثلة، وفي طليعتها: المادة الواسعة المتناثرة في مظان كثيرة، مثل: المصادر الدينية كالقرآن والحديث، ثم علوم الدين كالفقه وعلم الحديث والتفسير، ثم المصادر التاريخية والأدبية، ومنها كتب التراجم، والطبقات، والأخبار، فضلا عن المرويات السردية والشعرية.ويعود ذلك، فيما يعود، إلى أن الثقافة العربية-الإسلامية، بمظهرها الكلي، تكوّنت واستقامت في دائرة دينية واحدة، وذلك أدى إلى أن مكوناتها المتنوعة، تتصل فيما بينها، على صعيد الرؤية والمحتوى، وأحيانا الركائز والأنظمة والأبنية، على الرغم من توزعها بين حقول متعدّدة، الأمر الذي يلزم الباحث، فحص الأصول، واشتقاق مادة بحثه منها. واشتقاق مادة البحث من مظان لم يعتن بها، تحقيقا وتبويبا وفهرسة، يمثل عقبة أولى في هذا المجال، تليها مهمة تصنيف المادة ذاتها، وربما من المفيد في هذا السياق وصف الطريقة التي استخلصت بوساطتها مادة هذه الموسوعة الخاصة بالسرد العربي. إذ حدّدت الحقول الأساسية لمكوّنات الثقافة العربية-الإسلامية، وجرى حفر في مصادرها الأصلية دون وساطة مراجع حديثة، تقوم على قراءة تلك المصادر، قراءة محكومة بظرف خاص، قد تجهض الهدف الذي تتوخاه هذه الموسوعة، وهو استنباط البنية السردية للموروث الحكائي العربي القديم كما تشكلت في محاضنها الأصلية، ومتابعة تلك البنية في السرد العربي الحديث، مع الأخذ بالاعتبار تحديد الأنواع الكبرى وظروف النشأة. وأعقب ذلك تصنيف المادة، وأوصلت الثوابت فيما بينها، على النحو الذي تشكلت فيه، وأخضعت بعد ذلك للتحليل، سواء ما تعلق منها بالأطر العامة الموجهة للسرد، أم بالمتون السردية ذاتها.
نشأت المرويات السردية وسط منظومة شفوية من الإرسال والتلقي، وتكوّنت، أنواعا وأبنية، في ظل تلك المنظومة. ولم ينظر للسرد العربي بوصفه ركنا معرفيا من أركان الثقافة العربية، إنما نظر إليه، باعتباره مظهرا تمثيليا، استجاب لمكونات تلك الثقافة، فتجلّت فيه على أنها مكونات خطابية، انزاحت إليه بسبب هيمنة الموجهات الخارجية، وبخاصة الشفاهية والإسناد، فالسرد العربي خلفية تتمرأى فيها تلك الموجهات، وهو يقوم بعملية تمثيل لها" Representation" واقتضت هذه الرؤية للموروث السردي عملية منهجية تعومها، وتعبّر عنها، فاستعنّا بنوع من"الاستقراء الفني" الذي يستند إلى الاستنطاق تارة، والوصف تارة أخرى، إذ شخّصت الثوابت والمتغيرات في مادة البحث، وفيما تمّ استنطاق الأصول ابتغاء استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية، والخلفيات الثقافية، انصرف التحليل إلى كشف البنية السردية للنصوص نفسها، تلك النصوص الكبرى التي اندرجت مع الزمن ضمن أنواع أدبية معروفة، وراعى التحليل استنطاق الأصول المعرفية والسردية استنطاقا يتيح كشف المقاصد والمرامي التي تنطوي عليها تلك الأصول، ذلك أن الهدف لا يتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتها، إنما استنطاقها، بما يجعلها تسفر عما تكنّه، لتتضح طبيعة الموجّهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها في بنية الخطاب السردي.
اعتنى البحث بمنحى محدّد وهو" السرد" أو" القص" بوصفه مظهرا تمثيليا، تكوّن في محضن الثقافة العربية-الإسلامية، وتكيّف بفعل الموجهات الخارجية التي صاغت أنظمته، ثم تركزت تلك العناية، حول"سردية" ذلك المظهر، بغية استنباط أبنيته الداخلية، فـ"السردية" لا تعنى بالمتون السردية ذاتها، إنما بكيفيات ظهور مكوناتها سردياNarrativity أي بالممارسة التي اتخذتها مكونات السرد ضمن البنية السردية. وتجنب البحث إخضاع"السردية العربية"إلى معيار خارجي مستمد من موروث سردي آخر، فما كان يهدف إليه هو تحديد طبيعة السردية العربية، كما تكوّنت في نطاق المحضن الثقافي الذي تشكّلت فيه، وشخّصت الثوابت والمتغي
السردية العربية: مسارات صعبة
استغرق العمل على هذه الموسوعة نحو عشرين سنة. بدأ الإعداد لمادّتها الأولية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وتواصل بعدها، ولم ينقطع البحث في السرد العربي قديمه وحديثه منذ ذلك الوقت، ولكن من التمحّل القول بأن مشروع إعداد موسوعة تتتبّع نشأة السرديات العربية منذ العصر الجاهلي إلى نهاية القرن العشرين، ثم تتقصّى أبنيتها السردية والدلالية، كان واضحا في ذهني، جاهزا لا ينقصه سوى التنفيذ؛ فذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة، بل إنني أستطيع القول بأن فكرة الموسوعة بدأت تلوح لي في منتصف التسعينيات، حينما وجدت دراساتي في مجال السرد تتسع، وتتراكم، وتغطّي حقبا متتالية، فشرعت أعيد التفكير في الطريقة التي أكيّف فيها الدراسات والبحوث المنجزة والمخطط لها، بما يجعلها تخدم الغرض الذي أطمح إليه، وهو رسم المسار المعقّد للسردية العربية تكوينا وبنية في أثناء هذه الحقبة الطويلة، وتبيّن لي، وأنا أتولّى تدريس القديمة منها والحديثة لأكثر من عقد في عدد من الجامعات العربية في المشرق والمغرب، وأمارس البحث والكتابة في هذا المجال لنحو عشرين سنة، غياب الوعي بمسارها، فالمعلومات الشائعة إنما هي نبذ متناثرة، وتاريخية الطابع، ولا تهدف إلى ربط النصوص ببعضها ببعض، ولا تستنطق أبنيتها الدلالية، ولا تعنى بأصولها الشفوية، وعلاقتها بالنصوص الدينية.
وإذا كان القارئ العربي أنتج وعيا مختزلا بمسار الشعر العربي، بسبب الطريقة الخطية العتيقة التي سارت عليها كتب تاريخ الأدب، فقد حُرم، بصورة عامة، من معرفة السرديات العربية التي قامت بتمثيل المخيال العربي-الإسلامي، واختزنت رمزيا كل التطلّعات الكامنة فيه، والتجارب العميقة التي عرفها، وتخيلها. وتعرّضت، طوال أكثر من ألف وخمسمئة سنة، إلى سوء فهم، نتيجة التركيز على الشعر، من جهة أولى، وعدم امتثال معظم المرويات السردية القديمة لشروط الفصاحة المدرسية التي أنتجتها البلاغة العربية في العصور المتأخرة، تلك الشروط المعيارية التي أصبحت تحدّد قيمة الأدب، من جهة ثانية، وبسبب عدم اعتراف الثقافة المتعالمة بقيمتها التمثيلية سواء أكان ذلك عند القدماء أم عند المحدثين، إلا في حدود ضيقة، وذلك حينما تشكّلت الأنواع السردية القديمة، وحينما انبثقت الأنواع الجديدة من خضمّ التراث السردي المتحلّل الذي يعدّ رصيدها الأول، من جهة ثالثة. وبالإجمال فالسرديات العربية اختُزلت إما إلى وقائع تاريخية وإخبارية أو إلى أباطيل مُفسدة.
ويدرك كلّ من قيض له العمل في مجال الدراسات السردية، في الجامعات وسواها، الجهل شبه التام بالخلفيات الشفوية والدينية للمرويات السردية، والجهل بالعلاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي إلى أنواع مختلفة، والجهل بأبنيتها السردية والدلالية، والجهل بوظائفها التمثيلية، فكأن وعينا بأدبنا ناقص، وكأن تاريخ الأدب العربي يقفز على رجل واحدة. ولا يمكن الادّعاء بأن هذه الموسوعة ستجعله يسير على رجلين، فذلك أمر يتجاوز قدرتها، ويفوق طموحها، إنما تريد المساهمة في تنشيط الاهتمام بهذا الجانب، كونها وقفت على الأنواع السردية الأساسية، وتشكّلاتها، ضمن السياقات الثقافية الحاضنة لها، ولم تعن بالنصوص المتفرّقة التي لم تندرج ضمن الأنواع الكبرى، إلا في كونها أصولا لها أو تشقّقات عنها، فذلك مطمح كبير لم تتوفر عليه. ومعالجة النصوص السردية بطرائق منهجية حديثة لم تظهر في الثقافة العربية الحديثة إلاّ في الربع الأخير من القرن العشرين، والمحاولات القليلة السابقة كانت بدايات مهجّنة من دراسات متعدّدة في مناهجها ومرجعياتها، إلى ذلك فالاهتمام بتحليل السرد العربي القديم كان نادرا، ولم يبعث إلاّ فيما بعد، وما زالت تلك المادة الخام بأمسّ الحاجة إلى فحص نقدي عميق، يستخرج سماتها الأسلوبية، والبنائية، والدلالية، وذلك لا يتأتى إلاّ بجهد جماعي يلفت الانتباه إلى هذه الذخائر المطمورة في الأدب القديم.
يعرف المعنيون بهذا الموضوع صعاب التوغل في ذلك العالم شبه المجهول، المترامي الأطراف، الذي لم يُستكشف منه سوى جزء صغير، لأسباب ثقافية ودينيّة، ويعرفون القضية الأكثر خطورة وحساسية؛ وهي: العلاقات المتشابكة بين نشأة المرويات السردية، ونشأة النصوص الدينية، ونشأة الأخبار والتواريخ، وقصص الأنبياء والإسرائيليات، إلى حدٍّ أصبح فيه تخليص المرويات السردية من كل ذلك أمرا مستحيلا؛ إذ كانت العناصر المذكورة، بأطرها الثقافية الكلية، الحاضنة التي تشكّلت في وسطها تلك المرويات، فصاغت خصائصها الفنية صوغا شبه تام، وهذا هو السبب الذي دفعنا الى معالجة المرويات السردية ضمن السياقات الثقافية التي تكوّنت فيها. والأمر الآخر الذي يلاحظه كل متفحّص هو: الخصائص الشفوية للمرويات السردية، وذلك يعود إلى أنها ظهرت في أوساط شفوية يقوم الإرسال والتلقّي فيها على أسس متصلة بسيادة التفكير الشفوي، واسـتند ذلك التفكير إلى أصول دينية، فالشفاهية انتزعت شرعيتها في الفكر القديم بناء على أصول دينية، ومن هنا أصبحت ممارسة مبجّلة؛ لأنها عمّمت أسلوب الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على مجالات أخرى لا صلة لها بالدين. وبذلك أصبح الإسناد ركنا أساسا لا يمكن تجاوزه في المرويات السردية. وكان الإسناد يعامل دائما في الثقافة العربية القديمة، وبخاصة الدينية، على أنه جزء من الدين، انتقلت القداسة إليه بفعل المجاورة، مجاورته لمتون الحديث النبوي، كونه حاملاً لتلك النصوص المقدسة. وكما أن الصلة قوية ومتماسكة وضرورية بين السند والمتن، فقد تجلّت، بالصورة نفسها، في المرويات السردية بين الراوي والمروي، وهذا النسق لا يظهر الاّ في الثقافات الشفاهية، وقام التدوين بدور الوسيلة التي ثبّتت ذلك النسق وقيّدته، دون أن تخلخل العلاقة بين ركنيه الأساسيين المذكورين، إلى ذلك فالشفاهية هي التي منحت المرويات القديمة هويتها المميزة، وربط تلك المرويات بأصولها، والمؤثرات الفاعلة في تكوينها، لا يمثل أي خفض لقيمتها الأدبية أو التاريخية، إنما يصف واقع حالها.
ينتمي السرد العربي القديم إلى السرود الشفوية، فقد نشأ في ظل سيادة مطلقة للمشافهة، ولم يقم التدوين، الذي عرف في وقت لاحق لظهور المرويات السردية، إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي، ولم تكن الشفاهية نظاما طارئا بل كانت محضنا نشأت فيه كثير من مكونات الثقافة العربية في مظاهرها الدينية والتاريخية والأدبية واللغوية، فقداستمدت الشفاهية قوتها المعرفية من الأصول الدينية التي وجهتها توجيها خاصا، بما يجعلها تندرج في خدمة الدين، رؤية وممارسة. وتتحدّر المرويات السردية عن جذور شفوية، فهي"فن لفظي"(1) يعتمد على الأقوال الصادرة عن راو، يرسلها إلى متلقٍّ، ولهذا السبب كانت الشفاهية موجِّها رئيسا في إضفاء السمات الشفوية على الملاحم، والحكايات الخرافية والأسطورية، وجرى تمييز بين السرود الشفوية والسرود الكتابية، ولم يخضع التمييز لعامل الزمن كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيد، والثانية إلى العصر الحديث، إنما وضعت في الحسبان الخواص الفنية المميزة للبنى السردية في كل منهما، إذ اتصفت المرويات السردية الشفوية بأنها تتألف من"الراوي وحكايته والمتلقّي الضمني" أما السرود الكتابية، فإنها تتألف من"تمثيل" لكل من" الراوي وحكايته والمتلقّي الضمني"(2).
يقرن هذا التمييز السرود الشفوية بالبروز الكامل للمكونات السردية التي تكوّنها بما يجعل كل مكون عنصرا قائما ظاهرا؛ ذلك أن المرويات الشفوية لا توجد إلا بحضور جليّ لراو، ومرويّ له، ولا يمكن تغييب أي مكوّن، الأمر الذي يقرر أن تلك المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي الذي كان مهيمنا زمنا طويلا في البنية الذهنية للمجتمعات البشرية، كما أن ذلك التمييز، يحجب عن السرود الكتابية، صفة إشهار مكونات البنية السردية، وبها يستبدل نوعا من"التمثيل" لتلك المكونات، ولكنه لا يلغيها. وفيما يمكن القول بأن المرويات الشفوية تضع "مسافة" واضحة بين مكونات البنية السردية، فالراوي غالبا ما يكون متعينا، سواء بسماته أم بالمسافة التي تفصله زمانيا عما يروي، بحيث يروي أحداثا لا تعاصره، وقد لا ترتبط به إلا لكونه راويا لها فحسب، ونصطلح على هذا الراوي بـ" الراوي المفارق لمرويّه" لأنه يروي متونا لا تنتسب إليه، فإنّ تجليات" الراوي المتماهي بمرويه " تظهر بصورة أكثر في السرود الكتابية، وفي هذه السرود تغيب" المسافة" بين مكونات البنية السردية، وغالبا ما تختفي وراء" ضمير" يحيل على شخص مجهول، لا يعلن عن حضوره، ويتجنب الإشارة إلى نفسه، ويؤدي وظيفته في تشكيل المروي بوصفه جزءا منه، ولا يعنى بتوجيه خطابه مباشرة إلى مروي له ذي ملامح متعينة، وبذلك تكاد تتوارى الخصائص الشفوية، ويصبح الخطاب السردي وحدة كلية متجانسة، تتطلب تدقيقا وتفحصا من أجل كشف مكونات البنية السردية، ذلك أن الكتابة، على نقيض المشافهة، لا تستدعي انفصالا بين المؤلف والخطاب، شأن المشافهة التي تلزم ضرورة الانفصال بين الراوي والمروي؛ لأنها تستعين بالصوت المسموع وسيلة لها، فيما تعتمد الكتابة على الحرف أداة لصوغ الخطاب السردي. أفضى هذا التفريق إلى وصف السرود الشفوية بـ"العرضية" ووصف السرود الكتابية بـ" الدائمة"(3) لأن الأولى تتغير بتغير الرواة وعصورهم، فيما تظل الثانية خالدة، يمكن إعادة إنتاجها وتأويلها في أزمنة وأمكنة مختلفة، فضلا عن قدرة السرود الكتابية على الاندراج في سياق قراءات وتأويلات جديدة، كلما تغير الزمن، مع احتفاظها بالأصل الذي ظهرت فيه، فيما لا تتصف المرويات الشفوية بسمة الثبات والبقاء، الأمر الذي يعرّضها للتغيير والتزييف والفناء، بمرور الزمن.
2. السردية: حدود المفهوم
تُعنى السردية باستنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية، واستخراج النُظم التي تحكمها وتوجّه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها(4)، ووُصِفتْ بأنها "نظام نظري، غُذّي، وخصّب، بالبحث التجريبي"(5).وهي تبحث في مكونات البنية السردية للخطاب من راو ومروي ومروي له، ولما كانت بنية الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات، أمكن التأكيد على أن السردية،هي: المبحث النقدي الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي، أسلوبا وبناء ودلالة. والعناية الكلية بأوجه الخطاب السردي، أفضت إلى بروز تيارين رئيسين في السردية، أولهما: السردية الدلالية التي تعنى بمضمون الأفعال السردية، دونما اهتمام بالسرد الذي يكوّنها، إنما بالمنطق الذي يحكم تعاقب تلك الأفعال، ويمثل هذا التيار: بروب، وبريمون، وغريماس. وثانيهما: السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب، وما ينطوي عليه من رواة، وأساليب سرد، ورؤى، وعلاقات تربط الراوي بالمروي. ويمثل هذا التيار، عدد من الباحثين، من بينهم: بارت، وتودروف، وجنيت. وشهد تاريخ السردية محاولة للتوفيق بين منطلقات هذين التيارين، إذ سعى جاتمان وبرنس إلى الإفادة من معطيات السردية في تياريها: الدلالي واللساني، والعمل على دراسة الخطاب السردي بصورته الكلية، وفيما اتجه اهتمام برنس إلى مفهوم التلقّي الداخلي في البنية السردية، من خلال عنايته بمكوّن المروي له، اتجه اهتمام جاتمان إلى البنية السردية عامة، فدرس السرد بوصفه وسيلة لإنتاج الأفعال السردية، وبحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من الحوادث والوقائع والشخصيات التي تنطوي على معنى.وعدّ السرد نوعا من وسائل التعبير، في حين عدّ المروي محتوى ذلك التعبير، ودرسهما بوصفهما مظهرين متلازمين من المظاهر التي لا يتكوّن أي خطاب سردي من دونهما(6).
اشتقّ تودروف، في عام 1969، مصطلح Narratology بيد أنّ الباحث الذي استقامت على جهوده السردية في تيارها الدلالي، هو الروسي بروب(1895-1970) الذي بحث في أنظمة التشكّل الداخلي للخرافة الروسية حينما خصّها ببحث مفصّل انصب اهتمامه فيه على دراسة الأشكال والقوانين التي توجه بنية الحكاية الخرافية (7)، فأقرّ الباحثون اللاحقون في حقل السردية ريادته المنهجية والتاريخية في هذا المجال(
تتشكّل البنية السردية للخطاب، من تضافر ثلاثة مكونات: الراوي، والمروي، والمروي له. يُعرف الراوي، بأنه ذلك الشخص الذي يروي الحكاية، أو يُخبر عنها، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة"(11) ولا يشترط أن يكون اسما متعيّنا، فقد يتوارى خلف صوت، أو ضمير، يصوغ بوساطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع، وجرت العناية برؤيته تجاه العالم المتخيّل الذي يكوّنه السرد، وموقفه منه، واستأثر بعناية كبيرة في الدراسات السردية. أما المروي فهو كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث يقترن بأشخاص، ويؤطّره فضاء من الزمان والمكان، وتعدُّ "الحكاية" جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله، وفُرّق بين مستويين في المروي، الأول "متوالية من الأحداث المروية، بما تتضمنه من ارتجاعات واستباقات وحذف" واصطلح الشكلانيون الروس على هذا المستوى بـ"المبنى". والثاني" الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث" واصطلحوا عليه بـ"المتن"(12). المبنى يحيل على الانتظام الخطابي للأحداث في سياق البنية السردية، أما المتن فيحيل على المادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث، في سياقها التاريخي(13).
اتسع مجال البحث حول المبنى والمتن بوصفهما وجهي المروي المتلازمين، إذ ميز جاتمان بين "القصة" وهي سلسلة الأحداث، وما تنطوي عليه من أفعال ووقائع وشخصيات محكومة بزمان ومكان، و"الخطاب" وهو التعبير عن تلك الأحداث، وخلص إلى القول" إن القصة هي محتوى التعبير السردي، أما الخطاب فهو شكل ذلك التعبير"(14). والفرق بين المحتوى وكيفية التعبير عنه، فرق كبير، فالأول يحيل على المتن، فيما يحيل الثاني على المبنى. أما المروي له، فهو الذي يتلقّى ما يرسله الراوي، سواء أكان اسما متعينا ضمن البنية السردية، أم شخصا مجهولا. ويرى برنس" أن السرود، سواء أكانت شفوية أم مكتوبة، وسواء أكانت تسجل أحداثا حقيقية أم أسطورية، وسواء أخبرت عن حكاية أم أوردت متوالية بسيطة من الأحداث في زمن ما، فإنها لا تستدعي راويا، فحسب، بل مرويا له أيضا. والمروي له شخص يوجّه إليه الراوي خطابه، وفي السرود الخيالية – كالحكاية، والملحمة، والرواية - يكون الراوي كائنا متخيلا، شأن المروي له "(15). الاهتمام بالمروي له جعل البحث في البنية السردية أكثر موضوعية من ذي قبل، ذلك أن أركان الإرسال الأساسية، من راو ومروي ومروي له، استُكملت، مما سهّل فعالية الإبلاغ السردي، الذي هو الحافز الكامن خلف الأثر السردي. وتكشف أية نظرة إلى العلاقات التي تربط الراوي بالمروي وبالمروي له أن كل مكوّن لا تتحدّد أهميته بذاته، إنما بعلاقته بالمكونين الآخرين، وأن كل مكوّن سيفتقر إلى أي دور في البنية السردية، إن لم يندرج في علاقة عضوية وحيوية معهما، كما أن غياب مكوّن ما أو ضموره، لا يخلّ بأمر الإرسال والإبلاغ والتلقّي، فقط، بل يقوض البنية السردية للخطاب، ولذلك، فالتضافر بين تلك المكونات، ضرورة ملزمة في أي خطاب سردي
ليست السردية نموذجا تحليليا جامدا ينبغي فرضه على النصوص، إنما هي وسيلة للاستكشاف العميق المرتهن بقدرات الناقد، ومدى استجابة النصوص لوسائله الوصفية، والتحليلية، والتأويلية، ولرؤيته النقدية التي يصدر عنها، فالتحليل الذي يفضي إليه التصنيف والوصف، متصل برؤية الناقد، وأدواته، وإمكانياته في استخلاص القيم والسمات الفنية الكامنة في النصوص. وبما أن الدقة لا تتعارض مع كلية التحليل وشموليته، فالحاجة تفرض على السردية الانفتاح على العلوم الإنسانية والتفاعل معها، لأن كشوفاتها تغذّي السردية في إضاءة مرجعيات النصوص الثقافية والدينية، بما يكون مفيدا في مجال التأويل وإنتاج الدلالات النصية، ويمكن استثمارها في تصنيف تلك المرجعيّات، ثم كشف قدرة النصوص على تمثيلها سرديا، إلى ذلك يمكن أن توظّف في المقارنات العامة، ودراسة الخلفيات الثقافية كمحاضن للنصوص، ومن المؤكد أن ذلك يسهم في إضفاء العمق والشمولية على التحليل النقدي، بما يفيد السردية التي يظل رهانها متصلا برهان المعرفة الجديدة.
وشأنها شأن أي مبحث جديد، قوبلت السردية، في الثقافة العربية الحديثة، بالترحاب والمقاومة معا، ومرت مدة طويلة قبل أن تتخطّى الصعاب، وتنتزع الشرعية في بعض الأوساط الثقافية والأكاديمية، وإذا عدنا إلى السياق الثقافي الذي عُرفت فيه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، نجد انشطارا في المواقف كان قد تبلور حولها، فمن جهة أولى ضربت السردية الدراسات القديمة في الصميم، حينما نقلت النقد من الانطباعات الشخصية العابرة، والتعليقات الخارجية، والأحكام الجاهزة إلى تحليل الأبنية السردية، والأساليب، والأنظمة الدلالية، ثم تركيب النتائج في ضوء تصنيف دقيق، ومعمّق لمكونات النصوص السردية، وبذلك قدّمت قراءة مغايرة للنصوص السردية، ومن جهة ثانية، حامت شكوك جديّة حول قدرة السردية على تحقيق وعودها، لأن كثيرا من الدراسات السردية وقعت أسيرة الإبهام، والغموض، والتطبيق الحرفي للمقولات الجاهزة فيها، دون الأخذ بالحسبان السياقات المتفاوتة بين النصوص، والاختلاف في استخدام المفاهيم، ممّا أوقد شكّاً في القيمة العلمية للسردية، واحتاج الأمر جهدا كبيرا ينقّيها من الشوائب التي لحقت بها، ومن ذلك فقد طُرحت اجتهادات عدّة تهدف إلى تحقيق دلالة المصطلح النقدي الذي تستعين به، ولعل أبرز ما استأثر بالنقاش في هذا المجال، هو: مصطلح "السردية" الذي استخدمناه كمقابل لـ"Narratology"باعتباره المصطلح الأدق، والأكثر تعبيرا عن المفهوم، وجعلناه عنوانا لبحث الدكتوراه في عام 1988 إذ أوضحنا بأن المصدر الصناعي في العربية، يدل على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنه ينطوي على خاصية التسمية والوصف معا. فـ"السردية"بوصفها مصطلحا، تحيل على مجموعة الصفات المتعلّقة بالسرد، والأحوال الخاصة به، والتجليات التي تكون عليها مقولاته، وعلى ذلك فهو الأكثر دقة في التعبير عن طبيعة الاتجاه الجديد في البحث الذي يجعل مكونات الخطاب السردي وعناصره موضوعا له، كما أننا آثرنا الشكل البسيط للمصطلح، وسرعان ما شاع بسبب دقته وبساطته.
حيثما سيتردّد مصطلح" السردية العربية " في هذه الموسوعة، فلا يحيل على مقصد عرقي، إنما الهدف منه الوقوف على المرويات السردية القديمة، والنصوص السردية الحديثة، التي تكوّنت، أغراضا وبنى، ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة العربية، والتي كان التفكير والتعبير فيها يترتب بتوجيه من الخصائص الأسلوبية والتركيبية والدلالية لتلك اللغة، وكانت الشفاهية التي استندت إلى قوة دينية، جعلت اللغة العربية وسيلة التعبير الأساسية في ثقافة تتصل بها مباشرة، فهي لغة الخطاب الديني الذي ينطوي على تلك القوة، الأمر الذي مكّن اللغة العربية، بوساطة القوة الدينية، أن تمارس حضورها الثقافي في بلاد كثيرة، تستوطنها أعراق متعددة، قديما وحديثا، مما جعل مظاهر التعبير فيها تخضع لخصائص العربية وسماتها.
3. السرد: التلقّي والتواصل
ولا يمكن فهم أهمية السردية في تحليل النصوص إن لم تربط بنظرية"التلقّي" التي تعنى بتداول النصوص وتلقّيها، وإعادة إنتاج دلالاتها، سواء أكان ذلك في الوسط الثقافي الذي تظهر فيه، وهو ما نصطلح عليه بـ" التلقّي الخارجي" أم داخل العالم الفنّي التخيّلي للنصوص الأدبية ذاتها، وهو ما نصطلح عليه بـ" التلقّي الداخلي" ولا تكتسب نظرية التلقّي قيمتها المعرفية إلا إذا نُزلّت منزلتها الحقيقية، بوصفها نشاطاً فكرياً متصلاً بنظرية أكثر شمولاً هي نظرية" الاتصال" التي استفادت من البحث الفلسفي في مجال التواصل الذي يعتبر وسيلة التفاعل الأساسية بين الأفراد والجماعات، للتحكّم بالأنظمة المادية والرمزية، وبخاصة الآداب السردية، وهذا ما جذب اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكّر، وبخاصة فلاسفة مدرسة " فرانكفورت" الذين أفلحوا في تأسيس نظرية فلسفية نقدية، كان لها أكبر الأثر في تغذية الفكر الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعيين، وعلى يدي" هابرماز" استقام نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي تحوّل إلى "عقل أداتي" فطرح "هابرماز" مفهوم "العقل النقدي الاتصالي" الذي يرتبط بالحداثة فينتجها وتنتجه، معتبراً ذلك العقل الوسيلة التي تخرج بها الفلسفة من بعدها الذاتي الضيّق إلى أفقها الاجتماعي الواسع(16).
يصرّ "هابرماز" على أن هذا العقل قادر على الانخراط ضمن صيرورة الحياة الاجتماعية عبر التواصل، باعتبار أنّ أفعال الفهم المتبادل تلعب دور آليّة ترمي إلى تنسيق العمل، فالأعمال التواصلية تشكّل نسيجاً يتغذّى من موارد العالم المعيش، وتشكّل، نتيجة لذلك" الوسيط " الذي تعيد انطلاقاً منه أشكال الحياة العيانية إنتاج ذاتها(17). وإذا نظرنا إلى المؤثرات التي تركها الشكلانيون الروس، ومدرسة براغ، فضلاً عن " إنغاردن" و "غادامير"، ثم" ياوس" و" آيزر" في ظروف نشأة نظرية التلقّي، فإنها مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال، وكثيراً ما أشار روّاد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين الاثنين، بل ذهبوا إلى أنّ جهودهم تترتب ضمن أفق نظرية الاتصال، وهو ما أكده "ياوس" حينما قرّر أنّ نظرية التلقّي لا بد أن تبلغ مداها في نظرية أعم في الاتصال، لأن الاتجاهات النقدية الحديثة وضعت قضية الاتصال في صلب اهتمامها، فكل المحاولات التي تتبلور من أجل صياغة نظرية تلقّي الأدب، إنما هي متصلة بنظرية الاتصال، فالغاية من ذلك تقدير وظائف الإنتاج الأدبي والتلقي والتفاعل، وكل ما يتصل بذلك. ويشاركه في ذلك " آيزر" الذي يشتغل على مفاهيم البنية والوظيفة والاتصال، وجهوده قائمة على تنظيم صيغة التفاعل بين النص والقارئ، من أجل سريان الفاعلية بينهما، فهو يفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط مشترك بين القارئ والنص، بحيث يؤثّر أحدهما في الآخر من خلال عملية تنظيم تلقائية(18).
تعدّ نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي أثْرَتْ السردية. وكان الاهتمام بالتواصل الخارجي بين النصوص الأدبية والمتلقّين مثار عناية رواد نظرية التلقّي، وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين اللاحقين، لتنقل الاهتمام من التلقّي الخارجي إلى التلقّي الداخلي، الذي يُعنى بفحص طبيعة التراسل الداخلي في النصوص الأدبية، والسردية منها على وجه خاص، واندمج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة التي بلورتها الدراسات السردية التي تعمّقت في وصف مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها وأنظمتها الدلالية، وبُذلت جهود كبيرة في معاينة التلقّي الداخلي استنادا إلى فرضية أساسية، وهي: أنّ الإرسال السردي داخل النصوص لا بدّ أن يتم بين "الراوي" باعتباره قطب الإرسال، و"المروي له" بوصفه قطب التلقّي، فالمادة السردية إنما هي مداولة قوامها الإرسال والتلقّي، ولا ينبغي فهم دور" المروي له" على أنه دور من يتلقّى فقط، وينفعل بما يُرسل إليه، فوظائفه أكثر من ذلك، وقد حدّدها برنس، بأنها: تتصل بنوع التوسط بين الراوي والقارئ، وفي الكيفية التي يسهم فيها بتأسيس هيكل السرد، وتحديد سمات الراوي، وكشف مغزى النص، وتنمية حبكة الأثر الأدبي، وتحديد مقاصده(19). وكان جاتمان قد حدّد مستويات عدة للإرسال والتلقّي، تبعاً لنوع العلاقة التي تربط المرسل بالمتلقّي، فتوصّل إلى ضبط المستويات الآتية:
1. مستوى يحيل على مؤلف حقيقي، يُعزى إليه الأثر الأدبي، يقابله قارئ حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر.
2. مستوى يحيل على مؤلف ضمني، يجرّده المؤلف الحقيقي من نفسه، يقابله قارئ ضمني يتجه إلى الخطاب.
3. مستوى يحيل على راوٍ ينتج المروي، يقابله مروي له يتجه إليه الراوي.
ويرى جاتمان أنّ " النص السردي" يكون نتاجاً للمستويين الثاني والثالث، فإليهما تعود مهمة إنتاج الأثر السردي المجرّد قبل أن تغذّيه القراءة بإمكانات التأويل(20). وذهب جوناثان كلر المذهب ذاته، لكنه اشتقّ أربعة مستويات للتلقّي في النصوص السردية: مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارئ بالمعنى العام والخاص لكلّ منهما، ومستويان داخليان متصلان بالراوي والمروي له، سواء أكان ذلك متعلقاً بالراوي والمروي له بوصفهما مرسلاً ومتلقيّاً، أم بالمتلقّي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي، وليس الاقتصار على تلقيها(21). والوظيفة الأخيرة المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقي الداخلي. تقوم المكونات النصية الداخلية، وبخاصة الراوي والمروي له بتشكيل النسيج الدلالي والتركيبي للنصوص الأدبية، باعتباره فعالية تراسليّة تقوم على البث والتقبّل، والإرسال والتلقّي، وبذلك تتكوّن الأبعاد الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى إخراجها، ثم إعادة إنتاجها في ضوء البنية الثقافية الخارجية، حيث تكون خاضعة للوصف، والتحليل، والتفسير، والاستنطاق، والتأويل.
ويُدخل أمبرتو إيكو القارئ طرفاً أساساً في عملية خلق العوالم الافتراضية الممكنة للنصوص السردية إلى جوار المؤلف، لأنه يُدرج الأدب ضمن نظرية الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين، أحدهما يركّب رسالة ويقوم بإرسالها، والآخر يتلقّاها ويقوم بفكّ شفراتها، وإعادة بنائها بصورة عالم متخيّل، مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها النصية. والنص إنْ هو إلاّ نتاج يرتبط مصيره التأويلي أو التعبيري بآلية تكوينه ارتباطاً لازماً ؛ فأن يكوّن المؤلف نصاً يعني أن يضع حيّز الفعل استراتيجية ناجزة تأخذ في الحسبان توقّعات حركة المتلقي، شأن كل استراتيجية. وبعبارة أخرى فالنص نتاج لعبة نحوية –تركيبية-دلالية- تداولية، يشكّل تأويلها المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني الخاص، ولهذا يصبح الحديث عن عالم ممكن للنص ضرورياً، من أجل إثبات صحة الحديث حول توقّعات القارئ، الذي يقوم من عبر التلقّي بتنشيط المكونات السردية المتداخلة، بما في ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزماني- المكاني الذي يحتويهما، وذلك داخل سياق معين. وفي ضوء هذا التصور يعالج إيكو العوالم الافتراضية الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية في إشارة للصلات المحتملة بين العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية، فيقول " إنّ أي عالم حكائي لا يسعه أن يكون مستقلاً استقلالاً ناجزاً عن العالم الواقعي" بل إنهما يتداخلان ويأخذان المعنى الخاص بكلٍّ منهما من الخزين الثقافي للمتلقّي، لأنّ الواقع نفسه بنيان ثقافي، ويصبح أمر التراكب بينهما ممكناً وذلك بتحويلهما إلى كيانات متجانسة، وهنا تتبدّى الضرورة المنهجية لمعالجة العالم الواقعي باعتباره بنياناً، وكلما عمدنا إلى مقارنة سياقية ممكنة من الأحداث والأشياء كما هي، فإننا نتمثّل الأشياء كما هي، تحت شكل بنيان ثقافي، محدود، ومؤقت ومناسب. ولهذا يحدّد إيكو الأشكال التي يمكن أن تتخذها المقارنة بين العالمين:
1. يتسنّى للمتلقّي أن يقارن العالم المرجعي بحالات من الحكاية مختلفة، محاولاً أن يدرك إذا كان ما يجري يستجيب لمعايير الممكن الوقوع. وفي هذه الحالة، يقبل المتلقّي الحالات قيد المعالجة باعتبارها عوالم ممكنة.
2. يمكن للمتلقّي أن يقارن عالماً نصياً بعوالم مرجعية مختلفة، وذلك استناداً إلى نوع من المماثلة الممكنة بين أحداث العالمين، وقابلية حصولها، ويصار في هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناءً على نوع المخزون الثقافي لدى القارئ، ومدى خضوعه لنسق ثقافي يمكنه من التصديق أو التكذيب، فقارئ القرون الوسطى المشبّع بقيم الثقافة السائدة آنذاك يمكن أن يتلقّى الأحداث المرويّة في "الكوميديا الإلهية" على أنها ممكنة الوقوع، إلاّ أنّ قارئاً حديثاً يعتبر تلك الأحداث غير ممكنة الوقوع.
3. قد يتاح للمتلقّي أن يبني عوالم مرجعية مختلفة، أيّ منوّعة عن العالم الواقعي، وذلك حسب النوع الأدبي المعيّن، فالرواية التاريخية، على سبيل المثال، تتطلّب الرجوع إلى الخزين التاريخي، فيما تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب المشتركة. وهكذا يصار إلى التوفيق بين العالمين(22).
عرّف" فان ديك" السرد بأنه: وصف أفعال، يلتمس فيه لكلّ موصوف فاعلاً وقصداً وحالة وعالماً ممكناً وتبدلاً وغاية، فضلاً عن الحالات الذهنية والشعورية والظروف المتصلة بها، فالتنافد قائم بين عمليتي الإرسال والتلقّي، لأن السلسلة اللفظية المشفّرة التي يرسلها المؤلف، يقوم المتلقّي بحلّها في ضوء السياق الثقافي، وبذلك يشكّل عالماً خيالياً، يستمد دلالته من المضمرات النصيّة التي تستثار بعلاقاتها المختلفة بالمرجع، كما ذهب إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية يعتبر تتويجاً لدراسات تبدأ بالسياق التداولي، فالسياق المعرفي، ثم السياق الاجتماعي- النفسي، وأخيراً السياق الاجتماعي- الثقافي، وربط كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالنص الأدبي، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعملية فهمه، وتأثيره، وأخيراً تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعية، إذ يحدّد السياق الاجتماعي نوع الخصوصيات التي يمكن أن تطبع النصوص، والأنماط الشائعة منها، وقدرتها في الإحالة على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل بين النص والسياق الاجتماعي- الثقافي لا يحدد فحسب القواعد والمعايير الضرورية، إنما مضمون النصوص ووظائفها، وذلك ضمن أطر واضحة، ويعزو اختلاف الظواهر الثقافية، وشيوع أنواع من النصوص، بما في ذلك البنيات النسقية والأسلوبية والبلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل ونوعه وشروطه وعصره(23).
يتمّ التراسل بين المرجعيات بكل مكوناتها والنصوص على وفق ضروب كثيرة ومعقدة من التفاعل، فليس المرجعيات وحدها تصوغ الخصائص النوعية للنصوص، بل إنّ تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيات، وتسهم في إشاعة أنواع أدبية معينة وقبولها، ويظلّ هذا التفاعل مطّرداً، وسط منظومة اتصالية شاملة تسهل أمر التراسل بينهما، بما يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات والنصوص وأساليبها وموضوعاتها، وهي أنساق وأبنية سرعان ما تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعية والأدبية فيحصل انفصال بين هذه النماذج التجريدية من الأنساق، ودينامية الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك، قبل أن يعاد تشكيل العلاقات وفق أنساق جديدة.
4. موقع نظرية الأنواع الأدبية
ويحرص هذا التمهيد على إثارة قضية أخرى متصلة بالأنواع السردية القديمة التي سنقوم بدراستها بالتفصيل في هذه الموسوعة، وتلك القضية هي موقع" نظرية الأنواع الأدبية" في الأدب العربي، والحق فالنقد وتاريخ الأدب يكشفان ضآلة العناية بهذا الموضوع، بل إنهما يكشفان حالة متوترة من عدم الاتفاق بين مؤرخي الأدب والنقاد في كل ما يخص هذه القضية الشائكة، ويعود ذلك إلى الإخفاق في التفاهم حول مجموعة ثابتة من الشروط والقواعد التي يمكن الاهتداء بها لصياغة نتائج مقبولة وشبه نهائية، والبحث في موضوع "الأنواع الأدبية" والصعوبات الجمّة التي تعترضه، لا تقتصر على الأدب العربي، إنما يمثل مشكلة مزمنة في تاريخ الآداب العالمية، فمنذ أرسطو يثار دائما موضوع البحث في هذه القضية، وتستجد آراء وكشوفات، وفي ضوء ذلك يعاد ربط كثير من أشكال التعبير الأدبي بأصول مهملة، أو يصار إلى توسيع مفهوم "الجنس" أو "النوع" أو"النمط" أو"الشكل"، ومثل ذلك نجده عند"باختين "في ربطه الرواية بمظاهر التعبير الكرنفالية(24) فيما كان الشائع أنها سليلة الملحمة. وعند"جنيت" في توسيع مفهوم النوع، وإعادة دمج الأنواع والأشكال ببعضها ببعض، وإحداث تفريعات وتطويرات في التصورات الموروثة حول ذلك منذ أرسطو، وبلورتها ضمن إطار مفهوم "جامع النص"(25).
حاول البحث في هذا الموضوع، ضمن دائرة الثقافة العربية، التوفيق بين رسم تاريخ ظهور الأنواع الأدبية من جهة، والخصائص الفنية لتلك الأنواع من جهة ثانية، ومن الطبيعي أن يفضي بحث ينطلق من هذا التصور إلى الخلط بين التاريخي والنقدي، الأمر الذي لا يوفر في غالب الأحيان إمكانات لأي نجاح متوقع. ظهر هذا الخلط حينما اتخذ البحث طابع المفاضلة بين الشعر والنثر، ولم تستأثر قضية أسباب ظهور الآداب إلا بإشارات عابرة، في سياق مجادلات لم تعن بالهدف الجوهري الخاص بالتمايز النوعي بين النصوص، ولا البحث المقارن بين التطورات الأسلوبية والبنيوية للنصوص السردية والشعرية، وخلال كل هذا ظهرت لمحات عابرة عن النثر، بصورة عامة، وليس عن السرد. ويمكن إجمال كل ذلك بظهور قولين، الأول يقول بالتوقيف الإلهي الذي نادى به الباقلاني(403=1012) ومؤدّاه أن الله أوقف قول كل شيء على لسان البشر فلا دور لهم في ظهور شيء منه(26)، والثاني القول بالمواضعة والاصطلاح(27)الذي أخذ به ابن رشيق القيرواني(453=1061) بعد أن أثاره النهشلي(28) وفيه ألتُفتَ إلى البعد التاريخي الخاص بالآداب، وبأنها أشكال لغوية تواضع عليها البشر، واتفقوا على ضرورتها، فأخذوا بها للتعبير عن أنفسهم وعالمهم.
لم تندرج هذه الأقوال في سياق تصور تاريخي- نظري دقيق يؤرخ لتطورات الأدب العربي، وأجناسه الكبرى الشعرية والنثرية، إنما ظلت أقوال متناثرة في المظان القديمة، ومن ذلك أشار بعض القدماء إلى أسبقية ظهور الشعر، منهم: أبو عمرو بن العلاء (145=752) والأصمعي(215=730) وابن سلام الجمحي(232=846) والجاحظ(255=869) وغيرهم(29). وتبع هذا أن وردت إشارات أخرى حول خصائص الشعر، وتباينت وجهات النظر بين مجموعة من النقاد مثل ابن طباطبا (322=934) وقدامة بن جعفر(326=938)- على سبيل المثال-وهما يعتبران الشعر كلاما موزونا ومقفى وله معنى(30).ومجموعة من الفلاسفة كالفارابي(355=950)وابن سينا(428=1037) وابن رشد(595=1198)الذين يضيفون أنه كلام مخيل قوامه الأقاويل الشعرية(31). القضية الأساسية التي يمكن الإشارة إليها هنا، هي أنه لم يبذل جهد يذكر في دراسة الخصائص الفنية للأنواع، ولا تواريخ ظهور أشكال تعبيرية كثيرة انفصلت عن تلك الأنواع الكبرى، وكوّنت داخل خارطة الأدب العربي مواقع خاصة لها، وهي أشكال شعرية ونثرية تزايد تكاثرها بمرور الوقت. وبخاصة بعد أن راحت الآداب القديمة تتشقّق إلى أشكال تخرج عن أنواعه الأساسية، وتزدهر في مناطق مختلفة، ويمكن اعتبارها أنواعا فرعية قبل أن تستقل، وتصبح أنواعا كاملة.
انتبه ابن خلدون(808=1406) إلى ظاهرة التشقّق هذه، وعزاها إلى أن لغة البلاد الجديدة، خارج شبه الجزيرة العربية، التي عدّت الموطن الأصلي للجذور الدلالية الفصيحة للغة العربية، اختلفت بعض الشيء، بسبب المؤثرات الثقافية، عن اللغة الأم (32). فاللغة علامة تداولية تتفاعل بتأثير من الطبيعة التراسلية بين المتعاملين بها، وبالنظر إلى اتساع دار الإسلام(= وهو المصطلح الشائع في أوساط القدماء، طوال العصور الإسلامية الوسيطة) فقد ضمت بين أطرافها مواطن حضارية لها ثقافات مختلفة، سواء أكان ذلك في العراق أم سوريا أم شمال أفريقيا أم الأندلس أم فارس وما خلفها، وتلك الثقافات لم تطمس، إنما تفاعلت مع الثقافة العربية، فأنتجت ثقافة، بل ثقافات، لها طوابع محلية، فهي متصلة بثقافة شبه الجزيرة، ومنفصلة في الوقت نفسه عنها. متصلة بها، لأن كثيرا من مظاهرها ترتّب في ضوء القواعد الأسلوبية والبنائية والدلالية للغة العربية الفصحى، التي كانت وسيلة التعبير المعتمدة للثقافة، ومنفصلة عنها، لأنها تستلهم التقاليد، والمرجعيات، والموروثات الشعبية للمجموعات العرقية التي طورت ضروبا متنوعة من الثقافات الخاصة داخل ذلك الإطار العام. ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التعبير في الثقافة السائدة بين هذه المنطقة وتلك، فلا يمكن تصور مماثلة كاملة بين صيغ تعبير تؤدي وظائف محددة للجميع، كما أن انبعاث الموروثات القديمة، واللغات، وبقايا العقائد، والتقاليد، واستمرارها أو تكيّفها، يقود لا محالة إلى تمايز في درجات التعبير وأشكاله، وهو أمر ينمّي مع مرور الزمن أشكالا أدبية جديد، وهذه الأشكال - وهي أكثر التصاقا بالبيئات الشعبية المحلية، سواء باستثمار الموضوعات الموجودة في تلك البيئات، أو الاستعانة باللهجات السائدة، أو الصيغ الأسلوبية المتداولة- تبتدع مسارات خاصة تخرج بها على أنماط التعبير الكبرى، فتنتهك القواعد التي رسختها مع الزمن تلك الأنماط. وهي لا توقّر، في الغالب، الثقافة الرسمية المتعالمة التي تحوّلت إلى قوالب جامدة، تفرض أطرها العامة كنوع من التقليد، دون أن تنتبه إلى خلوها من الحيوية والتجدّد.
الثقافة الرسمية السائدة تتواطأ مع السلطة، وتستخدم من قبل هذه الأخيرة في تسويغ أفعالها، فيما تطور الثقافات المحلية أشكالا مختلفة من الرفض وعدم القبول، وحيثما تتعدّد الانتماءات العرقية والدينية، تتنوع الثقافات، وتختلف الرؤى والتصوّرات، وحيثما تتجمّد الحياة في تضاعيف الثقافة العامة، وتخمد الاجتهادات، ويتعثّر التجديد، وتظهر قوالب فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقّفت عن العطاء الحقيقي، تنبعث دماء الابتكار والتجديد في ثنايا الثقافات المحلية الخاصة؛ فتتوازى ثقافتان: ثقافة تجريدية تقرّ بالثبات، وتبجّل الماضي، وتقدّس المقولات، وتضع بينها وبين موضوعاتها مسافة؛ لأن آلياتها تشتغل ضمن أطر وقوالب، لا تأخذ في الاعتبار حاجات التغير والتلقّي، وثقافة حسية، وتشخيصية، ومهجّنة، لا تقرّ بالثبات، ولا تؤمن بالصفاء، إنما تتكون من موارد عدة متداخلة ومتفاعلة لا تعزل نفسها عن العالم الذي تظهر فيه، إنما تنشغل به انشغالا مباشرا، وللتعبير عنه، لا تتردد في تهجين أساليب تعبيرية متعددة، ولا تخشى إثارة موضوعات مختلف حولها. إنها ثقافة انتهاكية وغير امتثالية غايتها التحوّل. وفيما تثبّت الثقافة الأولى الأشكال والأساليب التي أنتجتها في ذروة تطورها، تقوم الثقافة الأخرى باستحداث أشكال متجدّدة، وفيما تريد تلك إخضاع الحياة لأطرها الثابتة، تريد هذه أن تتوافق أشكال التعبير في اطراد متقدم مع تجدّد الحياة. هذه الاصطراعات العميقة كانت فاعلة في صلب الثقافة العربية-الإسلامية، وسنجد أن نسق التحولات يصطدم، بين فترة وأخرى، بالركائز الصماء للتقاليد التي تفرزها الثقافة الرسمية، وسيكون السرد، بتطوراته النوعية والأسلوبية، هو المحك المعبّر عن هذه التحولات.
5. الرؤية والمنهج
ولكن ما الصعاب التي تواجه البحوث الشاملة التي تعنى بالآثار المعرفية والإبداعية لأمة من الأمم، أو تلك التي تنتدب نفسها لدراسة ظواهر أدبية- ثقافية كبيرة؟ وكيف يمكن أن تدرس؟ تتركّز تلك الصعاب حول مجموعة من المحاور الأساسية المتداخلة، وهي: طبيعة المادة موضوع البحث، والرؤية التي يصدر عنها الباحث، والمنهج الذي يتبعه، والأهداف التي يتوخّاها من بحثه، ويقتضي بيان ذلك شيئا من التفصيل. الصعاب تكاد تكون متماثلة، وفي طليعتها: المادة الواسعة المتناثرة في مظان كثيرة، مثل: المصادر الدينية كالقرآن والحديث، ثم علوم الدين كالفقه وعلم الحديث والتفسير، ثم المصادر التاريخية والأدبية، ومنها كتب التراجم، والطبقات، والأخبار، فضلا عن المرويات السردية والشعرية.ويعود ذلك، فيما يعود، إلى أن الثقافة العربية-الإسلامية، بمظهرها الكلي، تكوّنت واستقامت في دائرة دينية واحدة، وذلك أدى إلى أن مكوناتها المتنوعة، تتصل فيما بينها، على صعيد الرؤية والمحتوى، وأحيانا الركائز والأنظمة والأبنية، على الرغم من توزعها بين حقول متعدّدة، الأمر الذي يلزم الباحث، فحص الأصول، واشتقاق مادة بحثه منها. واشتقاق مادة البحث من مظان لم يعتن بها، تحقيقا وتبويبا وفهرسة، يمثل عقبة أولى في هذا المجال، تليها مهمة تصنيف المادة ذاتها، وربما من المفيد في هذا السياق وصف الطريقة التي استخلصت بوساطتها مادة هذه الموسوعة الخاصة بالسرد العربي. إذ حدّدت الحقول الأساسية لمكوّنات الثقافة العربية-الإسلامية، وجرى حفر في مصادرها الأصلية دون وساطة مراجع حديثة، تقوم على قراءة تلك المصادر، قراءة محكومة بظرف خاص، قد تجهض الهدف الذي تتوخاه هذه الموسوعة، وهو استنباط البنية السردية للموروث الحكائي العربي القديم كما تشكلت في محاضنها الأصلية، ومتابعة تلك البنية في السرد العربي الحديث، مع الأخذ بالاعتبار تحديد الأنواع الكبرى وظروف النشأة. وأعقب ذلك تصنيف المادة، وأوصلت الثوابت فيما بينها، على النحو الذي تشكلت فيه، وأخضعت بعد ذلك للتحليل، سواء ما تعلق منها بالأطر العامة الموجهة للسرد، أم بالمتون السردية ذاتها.
نشأت المرويات السردية وسط منظومة شفوية من الإرسال والتلقي، وتكوّنت، أنواعا وأبنية، في ظل تلك المنظومة. ولم ينظر للسرد العربي بوصفه ركنا معرفيا من أركان الثقافة العربية، إنما نظر إليه، باعتباره مظهرا تمثيليا، استجاب لمكونات تلك الثقافة، فتجلّت فيه على أنها مكونات خطابية، انزاحت إليه بسبب هيمنة الموجهات الخارجية، وبخاصة الشفاهية والإسناد، فالسرد العربي خلفية تتمرأى فيها تلك الموجهات، وهو يقوم بعملية تمثيل لها" Representation" واقتضت هذه الرؤية للموروث السردي عملية منهجية تعومها، وتعبّر عنها، فاستعنّا بنوع من"الاستقراء الفني" الذي يستند إلى الاستنطاق تارة، والوصف تارة أخرى، إذ شخّصت الثوابت والمتغيرات في مادة البحث، وفيما تمّ استنطاق الأصول ابتغاء استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية، والخلفيات الثقافية، انصرف التحليل إلى كشف البنية السردية للنصوص نفسها، تلك النصوص الكبرى التي اندرجت مع الزمن ضمن أنواع أدبية معروفة، وراعى التحليل استنطاق الأصول المعرفية والسردية استنطاقا يتيح كشف المقاصد والمرامي التي تنطوي عليها تلك الأصول، ذلك أن الهدف لا يتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتها، إنما استنطاقها، بما يجعلها تسفر عما تكنّه، لتتضح طبيعة الموجّهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها في بنية الخطاب السردي.
اعتنى البحث بمنحى محدّد وهو" السرد" أو" القص" بوصفه مظهرا تمثيليا، تكوّن في محضن الثقافة العربية-الإسلامية، وتكيّف بفعل الموجهات الخارجية التي صاغت أنظمته، ثم تركزت تلك العناية، حول"سردية" ذلك المظهر، بغية استنباط أبنيته الداخلية، فـ"السردية" لا تعنى بالمتون السردية ذاتها، إنما بكيفيات ظهور مكوناتها سردياNarrativity أي بالممارسة التي اتخذتها مكونات السرد ضمن البنية السردية. وتجنب البحث إخضاع"السردية العربية"إلى معيار خارجي مستمد من موروث سردي آخر، فما كان يهدف إليه هو تحديد طبيعة السردية العربية، كما تكوّنت في نطاق المحضن الثقافي الذي تشكّلت فيه، وشخّصت الثوابت والمتغي
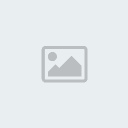
 من طرف
من طرف 
» مناهج النقد الأدبي . مترجم.rar
» مصطلحات توليدية
» ارجو المساعدة
» مساعدة عاجلة جداااااااااا
» كتب في علم الدلالة
» عرض حول معجم المقاييس لابن فارس
» المعجم الالكتروني
» تشغيل الجزيرة الرياضية بالشرينغ